حقيــــــــــقة التوحــــــــــــــــــيد
الذي بعث الله به الرسل
الذي بعث الله به الرسل
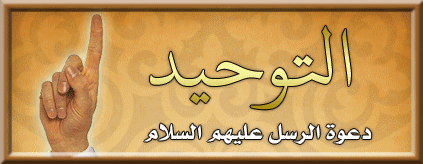
كتبه:
أبو عمار علي الحذيفي
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:
فهذه هي الحلقة الثانية من (دروس في التوحيد) نـتكلم فيها عن "حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الرسل". وتتكون هذه الحلقة من عدة فصول:
الأول: تعريف التوحيد: ويتكون من عدة مباحث:
المبحث الأول: معنى التوحيد.
المبحث الثاني: الأدلة على كلمة "توحيد".
المبحث الثالث: أركان التوحيد.
الثاني: توحيد الربوبية: ويتكون من عدة مباحث:
المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية، وأدلته.
المبحث الثاني: معاني الربوبية ترجع إلى ثلاثة الخلق والملك التدبير.
المبحث الثالث: إقرار المشركين بهذا التوحيد.
المبحث الرابع: إقرار المشركين به كان ناقصاً.
الثالث: توحيد الألوهية: ويتكون من عدة مباحث:
الأول: تعريف توحيد الألوهية، وأدلته.
الثاني: توحيد الألوهية هو المقصد من بعثة الرسل.
الثالث: وقت وقوع الشرك في الأمم، وكيفية وقوعه.
الرابع: خلاصة ما تقدم.
الرابع: توحيد الأسماء والصفات: ويتكون من عدة مباحث:
الأول: تعريفتوحيد الأسماء والصفات، وأدلته.
الثاني: الأمور التي يقوم عليها توحيد الأسماء والصفات.
الخامس: أنواع التوحيد: ويتكون من عدة مباحث:
المبحث الأول: ذكر الأنواع إجمالاً قبل تفصيلها.
المبحث الثاني: أدلة هذا التقسيم.
المبحث الثالث: المنكرون لهذا التقسيم وسبب الإنكار وثمرته.
المبحث الرابع: العلاقة والفرق بين هذه الأنواع الثلاثة.
المبحث الخامس:شبه القوم في نفي هذه الأنواع.
هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لها القبول عنده سبحانه، ثم عند خلقه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
الفصل الأول: تعريـف التوحــيد:
كثير من الناس يعرف فضل التوحيد، لكن صورة التوحيد التي بعث الله بها الرسل وحقيقته غير واضحة عنده، وإذا كان هذا يقع فيه كثير من أصحاب الشهادات ممن ينتسب إلى الفقه والتصوف وغيرهم، فكيف بغيرهم من الناس ؟! ولذلك أحببنا أن نبين "حقيقة التوحيد" في هذه الفصول التي نرجو من الله أن تساعد القارئ المبتدئ على تكوين صورة واضحة عن حقيقة التوحيد التي بعث الله بها الرسل.
المبحث الأول: معنى التوحيد:
التوحيد لغة: مصدر وحد يوحد توحيداً، أي: جعل الشيء واحداً،والتوحيد هو مصدر وحد على وزن فعّل بتشديد العين المهملة، وكل ما كان على وزن (فعّل) فمصدره على وزن (تفعيل) نحو درس يدرس تدريساً، وشغل يشغل تشغيلاً، وكلم يكلم تكليماً ومنه الآية: (وكلم الله موسى تكليماً) ونحو ذلك.
والتوحيد شرعاً: إفراد الله تعالى بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا يعني تنوع التوحيد إلى ثلاثة أنواع سيأتي الكلام عليها.
فالتوحيد في أصل اللغة والشريعة هو بمعنى الإفراد، فالتوحيد هو إفراده سبحانه بهذه الخصائص التي تفرد بها، فلا يشاركه فيها أحد مهما علت منزلته سواء كان ملكاً مقرباً أو نبياً مرسلاً أو رجلاً صالحاً.
وينبغي أن يعلم أن التوحيد بأنواعه لا يقوم حتى يجتمع الإقرار به في قلب العبد وعلى لسانه، والعمل به بجوارحه.
قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي في "كشف الشبهات": (لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلماً).
المبحث الثاني: الأدلة على كلمة "توحيد":
يزعم أعداء التوحيد أن كلمة "توحيد" كلمة مبتدعة ليس لها أصل وهذا قول باطل، فإن أصل كلمة التوحيد معروف في اللغة كما تقدم، ومعروف في الشريعة أيضاً، ونحن سنسوق هنا بعض الأدلة على أنها معروفة أيضاً.
أدلة القرآن:
قال تعالى: (وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً) وقال تعالى: (وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة)وقال تعالى: (ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير)وقال: (قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده) وقال: (وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده) وقال: (وما من إله إلا إله واحد) وقال: (وإلهكم إله واحد) وقال: (قل هو الله أحد) ونحو ذلك.
أدلة السنة:
1- قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: (إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى) وهو في "الصحيحين" وهذا لفظ البخاري.
2- وقال صلى الله عليه وسلم: (من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه، حرم ماله ودمه، وحسابه على الله) رواه مسلم وغيره عن طارق بن أشيم.
3- وفي حديث عمرو بن عبسة الطويل في "صحيح مسلم" وهو حديث مشهور قال عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم: (فقلت له ما أنت؟ قال: (أنا نبي) فقلت وما نبي؟ قال: (أرسلني الله) فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: (أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء).
4- وقال صلى الله عليه وسلم: (بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت) رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه، واللفظ لمسلم.
5- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة، وإن هشاماً نحر حصته خمسين بدنة وإن عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه لنفعه ذلك) رواه أحمد، وهو في "الصحيحة" برقم: (484).
6- وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في "صحيح مسلم" في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: (حتى إذا كان بالبيداء أهل بالتوحيد).
المبحث الثالث: أركان التوحيد:
1- ركنا التوحيد النفي والإثبات:
للتوحيد ركنان لا يُستغنى عنهما: الأول: هو النفي، والثاني: هو الإثبات، فلا يكون التوحيد توحيداً إلا بهذين الركنين، فالنفي فيه سلب ما يختص بالله عن غير الله، والإثبات فيه إفراد الله بهذه الأمور.
ونضرب على هذا مثالاً فنقول: لو أردنا أن نفرد زيداً بالعلم من بين الناس في بلد من البلدان، فلا يكفي أن نقول: (زيد عالم) لأن هذا فيه إثبات العلم لزيد لكن ليس فيه إفراد زيد بالعلم فيبقى احتمال أن هناك عالماً غيره، ولو قلنا: (لا عالم في البلد) لكنا قد نفينا العلم عن الجميع، وهذا فيه تعطيل، فالعبارة السـليمة أن نقول: (لا عالم إلا زيد) فنكون قد نفينا العلم عن غير زيد، وأثبتناه له وحده فقط.
ولذلك فألفاظ القرآن كلها في هذا الباب تدل على هذا الإفراد الذي ذكرناه بجميع صوره المعروفة في اللغة العربية، وصوره في اللغة العربية هي:
الأولى: تقديم ما حقه التأخير، مثل الظرف والجار والمجرور، وإنما قلنا حقها التأخير لأنها تأتي دائماً خبراً للمبتدأ على أحد الإعرابين، أو تتعلق بخبر محذوف على الإعراب الآخر، فإذا كانت كذلك فقد تقدمت فهي تفيد الحصر، مثل: (فابتغوا عند الله الرزق) ولم يقل: "فابتغوا الرزق عند الله"، فقوله: "فابتغوا عند الله الرزق" أي: عند الله وحده.
الثانية: أو تقديم المعمول مثل: (إياك نعبد، وإياك نستعين) والشاهد تقديم ضمير النصب، والمعنى: نعبدك وحدك، ونستعين بك وحدك.
الثالثة: النفي ثم الاستثناء، كقوله تعالى: (وما النصر إلا من عند الله)، وسواء كان الاستثناء بإلا أو غيرها من أدوات الاستثناء.
الرابعة: بوجود "إنما" بكسر الهمزة، كقوله تعالى: "يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي".
الخامسة: تعريف المبتدأ والخبر مثل: "الله الصمد"، والصَّمد: هو السيد العظيم الذي تُصْمد إليه الحوائج، أي يُقصد بها، والمعنى الله الذي يقصد بالحوائج، لا يُقصد بالحوائج والسؤال إلا هو وحده.
وإليك بعض هذا الإفراد المستفاد من الصور المتقدمة، فمن ذلك قوله تعالى: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) وهذا أمر بعبادة الله ونهي عن صرف العبادة لغيره فهذا توحيد، وقوله: (فاعلم أنه لا إله إلا الله) وهذا نفي وإثبات فهو توحيد، وقوله: (واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني لكم نذير مبين) وقوله تعالى: (ألا تعبدوا إلا الله) فيه النهي عن عبادة غير الله والأمر بعبادته وحده فدل على التوحيد، وقوله: (قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده) كذلك، وغير ذلك من الآيات.
2- معنى النفي الكفر بالطاغوت، ومعنى الإثبات والإيمان بالله:
واعلم أن النفي يحمل معنى الكفر بالطاغوت، وأن الإثبات يحمل معنى الإيمان بالله، والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هما الجناحان اللذان يطير بهما طائر التوحيد، كما قال تعالى: (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى) وكلمة التقوى والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، وقال تعالى: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) فالإيمان بالله وحده متوقف على الكفر بالطاغوت.
ومن هنا نعلم خطورة دعوى "حرية الاعتقاد" على عقيدة التوحيد ومصادمتها لهذه العقيدة العظيمة، لأن الكفر بالطاغوت منـزوع من قانون "حرية الاعتقاد"، فحرية الاعتقاد تعطي الحق لمن شاء أن يعبد ما شاء من الأوثان، في الوقت الذي تمنع الآخرين من الاعتراض عليه أو رد باطله، ولا شك أن هذا مصادم للكفر بالطاغوت الذي هو الركن الأول من أركان التوحيد، لأن الكفر بالطاغوت يوجب على الموحد التبرؤ من عبادة غير الله ومعاداة أهله صراحة وبكل وضوح، وهذا غير ما تجنيه هذه الدعوة المنحرفة على الجهاد في سبيل الله وهدم معالم الشرك، لأنه فرع الكفر الطاغوت.
والخلاصة أن دعوى "حرية الاعتقاد" تجني على مقاصد التوحيد وووسائله، ففيها فساد الدنيا والآخرة.
الفصل الثاني: توحيد الربوبية:
المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية، وأدلته:
1- تعريف توحيد الربوبية:
توحيد الربوبية: هو إفراد الله تعالى بأفعاله الدالة على ربوبيته التي لا يشاركه فيها أحد، كخلق الخلق وتدبيرهم والقيام على مصالحهم ومعايشهم وما تفرع من ذلك، لأن الرب عند العرب هو السيد المالك، فمعناه يتعلق بملكه وتدبيره ورعايته.
وأصل هذا التوحيد هو الاعتراف بأن الله هو الرب المتفرد بالخلق والملك والتدبير، ولذلك كان الأصل في هذا التوحيد أنه مما يتعلق بعمل القلب، والبدن تابع له، بخلاف توحيد الألوهية فإنه يتعلق بالقلب والبدن معاً.
2- أدلة توحيد الربوبية:
وتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى في ثلاثة أمور:
الأول الخلق: أي: أنه لا يقدر على الخلق إلا الله، والأدلة على ذلك كثيرة قال تعالى: (والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون) وقال تعالى: (أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم) وقال: (الله خالق كل شيء) وقال: (إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له) وقال: (هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه) وقال: (أفمن يخلق كمن لا يخلق) وقال: (واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون) وقال: (قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض) وقال: (قل هل من شركاءكم من يبدأ الخلق ثم يعيده) والآيات في ذلك كثيرة.
والمراد بالخلق هنا إيجاد الشيء من العدم وهذا لا يقدر عليه إلا الله، وإنما نقول ذلك لأن القبورية أثبتوا أن هناك من يخلق مع الله، بحجة أن الله أثبت خالقين آخرين غيره سبحانه، واستدلوا بقوله تعالى: (فتبارك الله أحسن الخالقين).
والجواب: أن الخلق الذي ينسب إلى المخلوق هو من باب تحويل الشيء من صورة إلى أخرى، كتحويل الطين إلى إبريق، وتحويل الخشب إلى دولاب، والماء إلى برد وثلج ونحو ذلك، وليس الخلق الذي هو إيجاد الشيء من العدم.
على أنه ينبغي التنبيه إلى أن بعض التحويل من شيء إلى شيء آخر هو بمنزلة إيجاد الشيء من العدم لا يقدر عليه إلا الله فقط، حتى المخلوق لا يقدر عليه، كتحويل النطفة منها إلى علقة والعلقة إلى مضغة والمضغة إلى عظام العظام إلى لحم ونحو ذلك.
والضابط في ذلك أن المخلوق لا يقدر على تحويل الشيء من صورة إلى أخرى إلا بوجود الأسباب التي هيأها الله، والخالق يقدر على ذلك بقوله كن فيكون.
الثاني الملك: أي: أنه تعالى متفرد بالملك، والأدلة في ذلك كثيرة، قال تعالى: (قل اللهم مالك الملك) وقال: (تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير) وقال: ( ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض) وقال: (ذلكم الله ربكم له الملك) وقال: (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك) وقال: (لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء) وقال: (له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى) وقال: (قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه) والآيات في ذلك كثيرة.
وتأمل في قوله تعالى: (بيده الملك) وقوله: (بيده ملكوت) وقوله: (له الملك) وقوله: (له ملك السموات ..) وقوله: (له ما في السموات والأرض) ونحو ذلك، تعرف إفراد الله بهذه المعاني بما تقدم من أساليب وطرق الإفراد في اللغة.
الثالث التدبير: أي: أنه تعالى متفرد بتدبير الأمور، وتصريف هذا الكون، قال تعالى: (وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون) وقال: (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه) وقال: (قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يـدبر الأَمـر) والآيات في إثبات تفرد الله بتصريف الأمور، وتدبير المعايش كثيرة.
المبحث الثاني: معاني الربوبية ترجع إلى ثلاثة الخلق والملك والتدبير:
وهناك معاني كثيرة أخرى من معاني الربوبية مثل الرزق والقبض والبسط، والإحياء والإماتة، وهبة الولد، وشفاء المريض، والنصر على العدو ونحو ذلك،وهي كثيرة نذكر منها:
1- الضر والنفع: فقد قال الله تعالى: (قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا) وقال تعالى: (ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك) وغير ذلك من الآيات.
والعلة من ذكر تفرده بالضر والنفع أن انتفاء ذلك عن هذه المعبودات دليل على عجزها في نفسها، فضلاً عن أن تملك لغيرها شيئاً، وأن الذي يستحق أن يعبد رغبة ورهبة هو الله لأنه مالك ذلك كله.
2- ومن ذلك الرزق: فهو الذي يسوقه ويأتي به ويسهله للخلائق، وكل ما يجده الناس في معايشهم من الأرزاق فهو من فضله وكرمه سبحانه وحده لا يشاركه في ذلك أحد.
قال تعالى: (إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له) فنفى أن يكون غيره يملك شيئاً من الرزق ولو يسيراً، وعرفنا ذلك بالأسلوب البلاغي في وجود النكرة في سياق النفي فنستفيد العموم أي: لا يملكون رزق المال ولا الأولاد ولا الطعام ولا الشراب ولا العافية ولا غير ذلك، ثم أمر بالتوجه إلى الله وحده وذلك بتقديم ما حقه التأخير حيث قدم الظرف فقال: (عند الله الرزق) ولم يقل: فابتغوا الرزق عند الله.
وقال تعالى: (هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض) فأفرد نفسه بالرزق ونفاه عن غيره، لأن هذا استفهام يراد به النفي، ومن ذلك قوله تعالى: (إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) وغير ذلك.
3- ومن ذلك شفاء المريض: فهو وحده الذي يشفي من المرض كما قال تعالى عن إبراهيم: (وإذا مرضت فهو يشفين) وفي الرقية كما في الحديث: (لا شفاء إلا شفاؤك).
4- ومن ذلك كشف الضرر: فإنه لا يقدر عليه إلا الله، كما قال تعالى: (وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو) وقال: (قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره) وقال: (فلما كشفنا عنهم الرجز) وقال تعالى: (فلما كشفنا عنه ضره) وغير ذلك من الآيات.
5- ومن ذلك أنه هو المتفرد بالرفع والخفض: كما قال تعالى: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) وقال: (ورفعنا لك ذكرك) وقال: (نرفع درجات من نشاء) وقال: (تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء) إلى غير ذلك من الآيات.
6- ومن ذلك هبة الولد وإخراجه من بطن أمه: قال تعالى: (يهب لم يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور) وقال عن زكريا عليه السلام: (فاستجبنا له ووهبنا له يحي) وقال: (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً) وقال: (ثم السبيل يسره) وقال: (ثم نخرجكم طفلاً).
7- ومن ذلك هداية القلوب وتسديدها وتوفيقها: قال تعالى: (من يهد الله فهو المهتد) ويقول: (إنك لا تهدي من أحببت) وقال: (وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) وغير ذلك من الآيات.
8- ومن ذلك النصر على العدو: كما قال تعالى: (وما النصر إلا من عند الله) وقال: (ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير) وقال: (إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده).
9- ومن التأليف بين القلوب: كما قال تعالى: (هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم) وقال: (واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً).
وغير ذلك من معاني الربوبية كالإحياء والإماتة، والقبض والبسط، والإعطاء والمنع وغير ذلك،وكلها ترجع إلى الخلق والملك والتدبير.
المبحث الثالث: إقرار المشركين بهذا التوحيد:
والمشركون كانوا يقرون بربوبية الله تعالى، وأنه خالق كل شيء كما في كثير من الآيات، منها قوله سبحانه وتعالى: (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم) وقوله سبحانه وتعالى: (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) وقوله سبحانه وتعالى: (قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون0سيقولون لله قل أفلا تذكرون0قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم0سيقولون لله قل أفلا تتقون0قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون0سيقولون لله قل فأنى تسحرون).
فهؤلاء الآيات بينت أن الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب المتفرد بالخلق والملك والتدبير كان مستقراً في نفوس المشركين، وأنهم لم يكونوا ينازعون في قضية ربوبية الله سبحانه وتعالى، ولم ينازعوا في أنه رب السموات والأرض، وأنه خالق الخلق ورازقهم سبحانه وتعالى، وإنما كانوا ينازعون في توحيد الله بالعبادة، فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه الأوثان والأصنام.
قال شيخ الإسلام كما "مجموع الفتاوى"(3/97): (وقد أخبر سبحانه عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه فى كتابه). ثم ساق بعض الآيات الدالة على ذلك.
وقال النعمي في "معارج الألباب إلى مناهج الحق والصواب": (ولقد تتبعنا في كتاب الله فصول تراكيبه، وأصول أساليبه، فلم نجده تعالى حكى عن المشركين أن عقيدتهم في آلهتهم وشركائهم التي عبدوها من دونه أنها تخلق وترزق وتحي وتميت وتنزل من السماء ماء، وتخرج الحي من الميت، والميت من الحي).
وقال: (ومن أمعن النظر في آيات الكتاب وما قص من محاورات الرسل مع أممهم وجد أن أس الشأن، ومحط رحال القصد شيوعاً، وكثرة وانتشاراً وشهرة هو دعاء الله وحده وإخلاص العبادة له).
ونحب أن ننبه إلى أننا نقول: إن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ولا يلزم من ذلك أنهم كانوا موحدين توحيداً صحيحاً مقبولاً.
وهناك شبهة للقبوريين في هذا العصر الذين ينكرون تقسيم التوحيد إلى عدة أقسام، والآيات التي فيها اعتراف المشركين ترد عليهم، لذلك قالوا: هذا الإقرار إنما قاله مشركو قريش نفاقاً، ولم يكونوا يعترفون بذلك في قرارة نفوسهم.
ويكفي أن نذكر وجهين في الجواب عن هذه الشبهة: الأول: هؤلاء الآيات مكية، والنفاق لم يظهر في مكة، وإنما ظهر في المدينة عندما قوي الاسلام بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فخاف بعض الناس أن يظهر الكفر فكان ينافق، أما في مكة فكانوا يجاهرون بالكفر، فما هناك أي ضرورة تحتم عليهم أن ينافقوا.
الثاني: أنهم لو كانوا منافقين في هذا الاعتراف والإقرار لعقَّب عليهم ربنا سبحانه وتعالى، وبين أنهم يقولون هذا عن نفاق لا عن تسليم وقناعة، وقد بين سبحانه وتعالى في أكثر من آية ما يقوله المنافقون من الكذب ويتعقبهم سبحانه وتعالى كما في قوله سبحانه وتعالى: (سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا) قال الله عز وجل بعدها: (يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم).
وآية أخرى وهي قوله سبحانه وتعالى: (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون)، والشهادة: هي تواطؤ اللسان والقلب على شيء، ومن المعروف أن المنافقين يقولون هذا بألسنتهم دون الإقرار بقلوبهم، فبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الأقوال يقولها المنافقون عن غير اعتقاد، وأنهم يكذبون في هذا الشهادة، فمن هنا نعرف أن إقرار كفار العرب بالربوبية عن إقرار حقيقي منهم، فلو كان كفار قريش كاذبين في هذا الإقرار لما أقرهم الله عز وجل.
المبحث الرابع: إقرار المشركين به كان ناقصاً:
وأيضاً نريد أن ننبه إلى مسألة مهمة وهي أن مشركي العرب عموماً، و مشركي قريش خصوصاً كانوا مقرين بتوحيد الربوبية بالجملة ولكن لم يكونوا مقرين به كاملاً، ولم يقروا به على الوجه المطلوب، بل كان عندهم خلل في توحيد الربوبية.
فمثال ذلك: أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث، فقد آمنوا بأن الله خلقهم لكن لم يؤمنوا بأن الله سيبعثهم، فهم آمنوا بالمبدأ ولم يؤمنوا بالمعاد، وأيضاً كانوا يستسقون بالأنواء بحيث إنهم يستسقون ببعض النجوم وبعض الأنواء والمنازل، كذلك كانوا يعلقون التمائم، والتمائم: "جمع تميمة وهي ما يعلقها الإنسان من جلد أو من خشب أو غير ذلك يريد بها دفع ضرر يتوقع حصوله، أو رفع ضرر قد حصل" فهم يعلقونها ويعتقد بعضهم أنها تنفع بإذن الله أو بنفسها، وكان فيهم التطير، وكان فيهم أشياء أخرى مما يخل بتوحيد الربوبية، ولكن بالجملة كان عندهم الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق والمالك والرازق والمتصرف في هذا الكون سبحانه وتعالى.
قال شيخ الإسلام كما في "درء تعارض العقل والنقل" (5/156): (وهم مع شركهم وما يلزمهم من نوع تعطيل في الربوبية لا يثبتون مع الله شريكاً مساوياً له في أفعاله ولا في صفاته).
وقال المقريزي في "تجريد التوحيد المفيد": (فأبان سبحانه بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الألوهية لا توحيد الربوبية، على أن منهم من أشرك في الربوبية كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله).
الفصل الثالث: توحيد الألوهية:
المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية، وأدلته:
1- تعريف توحيد الألوهية:
توحيد الألوهية: هو إفراد الله بأفعال العباد، أي: بعبادتهم فقط، وليس المقصود إفراده تعالى بجميع أفعال العباد، فإن من أفعالهم ما هو من قسم المباحات كالأكل والشرب وغيرهما.
وهذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، فإن هذه الكلمة تدل على توحيد الألوهية بدلالة المطابقة كما تقدم.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: (وأحسن ما يعرف هذا التوحيد هو قوله تعالى: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) وقوله: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) أ.هـ
ويسمى توحيد الألوهية والإلهية وتوحيد العبادة ونحو ذلك.
قال الشيخ ابن سعدي في "القواعد الحسان": (ويقال له توحيد الإلهية، فإن الإلهية وصفه تعالى الذي ينبغي أن يؤمن به كل بني آدم، ويوقنوا أنه الوصف الملازم له سبحانه الدال عليها الاسم العظيم وهو الله، وهو مستلزم جميع صفات الكمال، ويقال له: توحيد العبادة باعتبار وجوب ملازمة وصف العبودية بكل معانيها للعبد بإخلاص العبادة لله تعالى، وتحقيقها في العبد أن يكون عارفاً بربه، مخلصاً جميع عبادته محققاً ذلك بترك الشرك صغيره وكبيره).
2- أدلة توحيد الألوهية:
وهذه الألوهية تعني تفرد الرب بحق العبادة فلا يشاركه في ذلك أحد، قال تعالى: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) وقال: (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) وقال: (إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه) وقال: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم) – إلى قوله: - (فلا تجعلوا لله أنداداً) وقال: (قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون) وقال: (قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دونه) وقال: (قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب) وقال: (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله) وقال: (واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله) وقال الله عن الكفار أنهم قالوا: (أجئتنا لنعبد الله وحده).
الثاني: توحيد الألوهية هو المقصد الأعظم من بعثة الرسل:
1- توحيد الألوهية هو دعوة الرسل في الأصل:
والمقصود الأعظم من دعوة الرسل هو تحقيق هذا التوحيد، وإن كانوا أيضاً قد جاءوا لتحقيق سائر أنواع التوحيد، لكن هذا التوحيد كان في المقدمة لأن الشرك الذي وقع للأمم كان من جهته.
فتوحيد العبادة أمرت به جميع الشرائع، وأقامته جميع الملل كما قال تعالى: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقال تعالى: (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون)وقال تعالى: (لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) وغير ذلك من الآيات، وقد تقدم هذا في الدرس الأول "مكانة التوحيد".
والمشركون أنفسهم فهموا هذا الذي ذكرناه من أن الرسل بعثوا لينهوا أممهم عن عبادة غير الله فقال الله عنهم: (قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده) وقال: (أجعل الآلهة إلهاً واحداً).
2- أسلوب القرآن في الدعوة إلى الألوهية:
وللقرآن أسلوب خاص في دعوته إلى توحيد الألوهية فمن ذلك:
1- إلزام من أقر بالربوبية بتوحيد الألوهية، فالله يعلم أن مشركي قريش يقرون في باب الربوبية بالجملة، ويعلمون في قرارة أنفسهم أنه لا يشارك الله أحد في ربوبيته للخلائق، فجعل إقرارهم هذا ملزماً لهم في توحيد العبادة في أكثر من آية.
قال شيخ الإسلام كما "مجموع الفتاوى" (14/180): (أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون وكانوا يعبدون مع الله غيره ويحبونهم كما يحبونه، فكان ذلك التوحيد - الذي هو توحيد الربوبية - حجة عليهم).
وقال ابن القيم في "طريق الهجرتين" (56-57): (ولهذا كانت لا إله إلا الله أفضل الحسنات، وكان توحيد الإلهية الذي كلمته لا إله إلا الله رأس الأمر، فأما توحيد الربوبية الذي أقر به كل المخلوقات فلا يكفي وحده وإن كان لا بد منه وهو حجة على من أنكر توحيد الألوهية).
ومن هؤلاء الآيات قوله تعالى: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون) والمراد كما أشار غير واحد من المفسرين أنه إذا أقررتم أنه الخالق لكم ولغيركم فكيف تعبدون غيره ؟!
قال ابن كثير عند هذه الآية: (ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غَيره).
وقال رحمه الله عند آيتي العنكبوت (ولئن سألتهم): (وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية فإن المشركين كانوا يعترفون بذلك).
2- ومنها بيان أن الله خلق الخلق لعبادته وحده سبحانه، وأن الذي صرف العبادة لغيره لم يحقق العبودية المطلوبة لله والعبادة المطلقة، وأن الله لم يخلق الناس عبثاً، ولم يتركهم سدى لا يؤمرون ولا ينهون، بل خلقهم لعمارة هذا الكون بالطاعة والعبادة.
3- ومنها أنه خاطبهم على قدر عقولهم فضرب له الأمثلة الكثيرة ومنها: أنه أخبر أن السيد كما أنه لا يسره أن يشاركه عبده ومملوكه في ماله فكذلك الله جل وعلا لا يحب أن يشاركه أحد، فهكذا الرب الذي يخلق الخلق ثم يعبدون غيره.
قال تعالى: (ضَرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون).
قال ابن كثير في "تفسيره": (هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به العابدين معه غيره، الجاعلين له شركاء وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له ملك له، لا يرتضي أحد منكم أن يكون عبده شريكًا له في ماله، فهو وهو فيه على السواء، تخافون أن يقاسموكم الأموال) أ.هـ
3- خطأ من يرى أن توحيد الربوبية هو غاية دعوة الرسل وغيرها:
وهناك من الطوائف من ترى أن الغاية الذي بعث الله لها الرسل هو الإيمان بأن الله هو الخالق والمدبر للخلائق وهذا غير صحيح.
قال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" (3/97-98): (وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد فى كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع: فيقولون هو واحد فى ذاته لا قسيم له، وواحد فى صفاته لا شبيه له، وواحد فى أفعاله لا شريك له.
وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا: (لا اله الا الله) حتى يجعلوا معنى الإلهية القدرة على الاختراع.
ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه و سلم أولا لم يكونوا يخالفونه فى هذا بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء حتى أنهم كانوا يقرون بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون، فقد تبين أن ليس فى العالم من ينازع فى أصل هذا الشرك) أ.هـ
وقال ابن القيم في "طريق الهجرتين" (ص30): (وغاية هذا الفناء في توحيد الربوبية وهو أن لا يشهد رباً وخالقاً ومدبراً إلا الله، وهذا هو الحق ولكن توحيد الربوبية وحده لا يكفي في النجاة فضلاً عن أن يكون شهوده والفناء فيه هو غاية الموحدين ونهاية مطلبهم، فالغاية التي لا غاية وراءها ولا نهاية بعدها الفناء في توحيد الإلهية).
وقال ابن القيم في "طريق الهجرتين" (56-57): (ولهذا كانت لا إله إلا الله أفضل الحسنات، وكان توحيد الإلهية الذي كلمته لا إله إلا الله رأس الأمر، فأما توحيد الربوبية الذي أقر به كل المخلوقات فلا يكفي وحده وإن كان لا بد منه وهو حجة على من أنكر توحيد الألوهية).
الثالث: وقت وقوع الشرك في الأمم، وكيفية وقوعه:
روى البخاري في "صحيحه" برقم: (4920) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون أنصاباً، وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت).
قال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" (1/167): (وقد استفاض عن ابن عباس وغيره في "صحيح البخاري" وفي كتب التفسير وقصص الأنبياء في قوله: (وقالوا لا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً) أن هؤلاء كانوا قوماً صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم، قال ابن عباس: ثم صارت هؤلاء الأوثان في قبائل العرب) أ.هـ
ثم جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فبقي الناس على ملته حتى جاء من غير ملته فأحيى عبادة الأصنام مرة أخرى، وكان أول من أحيا عبادة الأصنام بين العرب هو عمرو بن لحي الخزاعي، فقد كان الناس على ملة إبراهيم حتى جاء هذا الرجل فأخرجها في بعض أسفاره من الرمال بوحي من الشيطان فنقلها إلى جزيرة العرب، ودعا الناس إلى عبادتها فاستجابوا له لما له بينهم من جاه وسلطان.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": (وقد أخرج الفاكهي من طريق ابن الكلبي قال: " كان لعمرو بن ربيعة رئي من الجن فأتاه فقال: أجب أبا ثمامة، وادخل بلا ملامة ثم ائت سِيْفَ جدَّة، تجد بها أصناماً معدة، ثم أوردها تهامة ولا تهب، ثم ادع العرب إلى عبادتها تجب، قال فأتى عمرو ساحل جدة فوجد بها وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً، وهي الأصنام التي عبدت على عهد نوح وإدريس، ثم إن الطوفان طرحها هناك فسفى عليها الرمل فاستثارها عمرو وخرج بها إلى تهامة وحضر الموسم فدعا إلى عبادتها فأجيب) أ.هـ
المبحث الرابع: خلاصة ما تقدم:
حتى لا يبقى القارئ مشتتاً بين هذه المباحث أحببنا أن نلخص له ما تقدم ذكره إلى أمور، فنقول وبالله التوفيق:
الأول: أن الناس كانوا على الفطرة والتوحيد حتى وقع الشرك في قوم نوح أو قبلهم بقليل ثم سارت الأمم على هذه الطريقة، يخرجهم الشيطان عن فطرتهم بهذا النوع من الشرك.
الثاني: أن شركهم لم يكن من جهة اعتقاد أن هناك من يتصرف في هذا الكون مع الله أو أنه يخلق أو يرزق أو غير ذلك من معاني الربوبية، وإنما لكونهم صرفوا العبادة لغير الله.
الثالث: أن عباد الأوثان لم يكونوا يعتقدون أن هذه المعبودات تضر وتنفع بنفسها، ولكن صرفوا لها العبادة لتقربهم إلى الله زلفى فقط، لما يرونه من فضل هؤلاء الصالحين وقربهم من الله.
الرابع: أن الرسل إنما جاءت لإفراد الله بالعبادة، وبينت أن صرف العبادة لغير الله من الشرك العظيم الذي يوجب قتال أهله، وأن حسن النية التي يتحجج بها هؤلاء لا تنفعهم عند الله.
وقد تشذ عما ذكرناه بعض الصور، ولكن هذا نادر ولا يؤثر فيما تقدم، والأصل ما ذكرناه.
الفصل الرابع: توحيد الأسماء والصفات:
الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات، وأدلته:
1- تعريف توحيد الأسماء والصفات:
وتوحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته التي وصف بها نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، مع الإقرار بمعانيها إثباتاً بلا تمثيل، وتنزيهاً بلا تعطيل.
والأسماء: هي الكلمات الدالة على ذاته مثل الرحمن والرحيم والعزيز والغفور ونحوها.
والصفات: هي المعاني القائمة بالذات كالرحمة والعزة ونحوهما.
وهذا التوحيد مندرج في الأصل في توحيد الربوبية.
قال الشيخ الفوزان في "شرح كتاب التوحيد": (النوع الثالث: وهو توحيد الأسماء والصفات، فهو في الحقيقة داخل في توحيد الربوبية، ومن أجل هذا بعض العلماء يجمل ويجعل التوحيد نوعين:
توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وهو التوحيد العلمي، وتوحيد في الطلب والقصد وهو التوحيد الطلبي العملي، وهو توحيد الألوهية) أ.هـ
2- أدلتــه:
وعندنا على هذا التوحيد أدلة كثيرة مستفيضة من الكتاب والسنة كقوله تعالى: (ولله المثل الأعلى) أي: الوصف الأعلى وقوله تعالى: (ليس كمثله شيء) وقوله: (ولم يكن له كفوا أحد) وقوله: (هل تعلم له سمياً) وقوله: (فلا تجعلوا لله أنداداً) والند يكون في الصفات كما يكون في الربوبية والألوهية، ونحو ذلك من الأدلة التي تبين تفرده بهذه الأسماء والصفات التي سمى بها نفسه بها أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم.
الثاني: الأمور التي يقوم عليها توحيد الأسماء والصفات:
وتوحيد الأسماء والصفات مبني على أمور لا يقوم توحيد الأسماء والصفات إلا بها:
الأول: أن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وينفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن نعتقد أن هذه الأسماء والصفات خاصة بالله، لا يشاركه فيها أحد من الخلق مهما علت منزلته، أو عظمت مكانته، فلا نصف أحداً من الخلق بعلم الغيب أو العلو المطلق أو الاستواء على العرش أو نحو ذلك من الصفات، ولا نسميه بالأسماء الخاصة بالله كالرحمن أو الإله أو الرب أو الله أو نحو ذلك من الأسماء.
الثالث: إثبات المعاني الواردة في النصوص على ما يليق بالله تعالى إثباتا بلا تمثيل.
الرابع: أن نفوض الكيفية فلا نخوض فيها لأننا لا نعلمها كما قال الإمام مالك: (الاستواء معلوم، والكيف مجهول).
فإذا سار العبد على هذه الأصول العظيمة سلم له معتقده في باب "الأسماء والصفات".
الفصل الخامس: أنواع التوحيد:
المبحث الأول: ذكر أنواع التوحيد إجمالاً قبل تفصيلها:
التوحيد ثلاثة أنواع هي: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وهذه الأنواع الثلاثة لابد للعبد من الإتيان بها كلها، ولا نجاة له إلا بذلك.
وفي الوقت نفسه لا بد من التفريق فيما بينها، بمعنى أنها ليست توحيداً واحداً كما يظن من لم يعرف حقيقة التوحيد، فبعض الطوائف يظنون أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية واحد لا فرق بينهما، ولذلك فهم يرون غاية دعوة الرسل هو الإيمان بأن الله هو الخالق، وأن من آمن بذلك فقد أتى بكلمة التوحيد، فأنتج هذا القول ثماراً سيئةً منها أن التوحيد المطلوب من الناس أن الله هو الخالق القادر على خلق الشيء من العدم، وعليه فإنهم لا يعدون صرف شيء من العبادة لغير الله مناقضاً للتوحيد.
ونحن سنذكر هذه الأنواع الثلاثة مع ذكر ما استطعنا من الأدلة عليها، والله الموفق.
المبحث الثاني: أدلة هذا التقسيم:
تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام دليله ثلاثة أشياء: الاستقراء التام، ودلالة كلمة لا إله إلا الله، وتنصيص السلف وأئمة الدين والعلم.
الدليل الأول الاستقراء التام:
والاستقراء التام: هو الحكم على شيء كلي بواسطة إثباته بالتتبع والتصفح لجميع الجزئيات، وهو حجة بإجماع الأصوليين.
قال الشنقيطي في "الأضواء": (وقد تقرر في الأصول: أن الاستقراء من الأدلة الشرعية، ونوع الاستقراء المعروف عندهم بالاستقراء التام حجة بلا خلاف، وهو عند أكثرهم دليل قطعي).
وقال الشنقيطي في "الأضواء" في موضع: (وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: توحيده في ربوبيته، وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء، قال تعال: (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) وقال: (قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون) وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله: (قال فرعون وما رب العالمين) تجاهل من عارف أنه عبد مربوب بدليل قوله تعالى: (قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر)، وقوله: (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلواً) وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله. كما قال تعالى: (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) والآيات الدالة على ذلك كثيرة جداً.
الثاني: توحيده جل وعلا في عبادته، وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى: (لا إله إلا الله) وهي متركبة من نفي وإثبات، وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد، وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم (أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب).
النوع الثالث: توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته، وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين:
الأول: تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم، كما قال تعالى: (ليس كمثله شيء).
والثاني: الإيمان بما وصف الله به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بكماله وجلاله، كما قال بعد قوله: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) أ.هـ باختصار.
وأقول إن كثيراً من أبواب العلم بنيت على الاستقراء، ومن ذلك أن النحويين قسموا الكلمة إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، ودليلهم على هذا استقراء تام لكلام العرب، والصوفية القبورية يسلمون بهذا التقسيم ولا يناقشون فيه، وحجة هذا التقسيم هو حجة تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، مع أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أظهر وأبين وأوضح، لأن أدلته هي الكتاب والسنة وقد نطق به السلف الصالح، وسيأتي معنا بعض الآيات الدالة على هذا الشيء.
وإذا قلنا: إن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح، فهل يمكن أن يقال: إن هذا لم ينص عليه الشرع وإنما هو تثليث، وإن كان العلماء يستندون في ذلك التقسيم إلى نصوص الشريعة ويعتمدون على استقراء تام لها ؟!
فقولنا: "الإيمان: قول وعمل واعتقاد" لم يدل عليه دليل شرعي يحمل هذا اللفظ، وإنما هو مأخوذ من جملة الأدلة، ومعتمد على استقرائها، وإنما ذكر العلماء هذا التفصيل لما ظهرت الأقوال الزائغة.
وأيضاً تقسيم الكلمة إلى ثلاث أقسام: الاسم، والفعل، والحرف الذي جاء لمعنى، وهو شيء يعرفه "الصوفية"، فهل العرب نصت على هذا التقسيم بعينه ؟!
وأيضاً أغلب هؤلاء القبوريين على عقيدة "الأشاعرة" وهم يقولون: إن توحيد الله ينبني على ثلاثة أشياء:
توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الأفعال، وهذا التقسيم عليه ملاحظات كثيرة من حيث هو، ولكن أردنا أن نبين أن القبوريين المنكرين للتقسيم العلمي للتوحيد، هم أنفسهم يقرون بتقسيم آخر وإن كان ليس مبنياً على أسس صحيحة.
الدليل الثاني دلالة كلمة "لا إله إلا الله":
فكلمة التوحيد تدل على إفراد الله بالعبادة بدلالة المطابقة، لأن معنى "كلمة التوحيد": "لا إله إلا الله" هو إفراد الله بحق العبادة ونفي هذا الحق عن غيره، و"الإله" لا يكون مستحقاً لهذه العبادة إلا إذا كان رباً خالقاً مدبراً لمصالح عباده، فهذا توحيد الربوبية وقد عرفناه بدلالة التضمن، والرب موصوف بصفات الكمال والجلال، وهذا توحيد للأسماء والصفات، وقد عرفناه بدلالة الالتزام.
الدليل الثالث: طريقة السلف، وتنصيص الأئمة:
قال سبحانه وتعالى: (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) فأثبت سبحانه وتعالى في الآية إيماناً للمشركين من جهة، وشركاً وقعوا فيه من جهة أخرى، فقد قال العلماء في معنى الآية: (وما يؤمن أكثرهم بالله) أي: في جانب الربوبية (إلا وهم مشركون) أي: في جانب العبادة.
قال ابن كثير في تفسيره في "تفسيره" "سورة يوسف" قال ابن عباس: "من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم: من خلق السموات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال ؟ قالوا: الله، وهم مشركون به" يعني في العبادة).
قال ابن كثير: (وكذا قال مجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم).
وللأئمة كلام نصوا على هذا التفصيل والتقسيم ونقلوه عن غيرهم، ويكفي أن أذكر ثلاثة من هؤلاء الأئمة الذين شهد لهم الناس بإمامتهم بالعلم، وسنشير إلى الباقي:
1- ما قاله الطحاوي في أول "عقيدته": (نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولاشيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره).
فقوله: (ولا شيء مثله) فيه الإشارة إلى توحيد الأسماء والصفات، وقوله: (ولا شيء يعجزه) فيه إشارة إلى توحيد الربوبية، وقوله: (ولا إله غيره) فيه إشارة إلى توحيد الألوهية.
وهذا التفصيل عليه أئمة الحنفية وهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ثم محمد بن الحسن، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، وقد أشار الطحاوي في مقدمة "عقيدته" إلى أن رسالته هذه هي على معتقد الأئمة الثلاثة.
2- ما قاله ابن بطة في "الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية": (وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء:
أحدها: أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مبايناً لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعاً.
والثاني: أن يعتقد وحدانيته، ليكون مبايناً بذلك مذاهب أهل الشرك، الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره.
والثالث: أن يعتقده موصوفاً بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفاً بها من العلم والقدرة والحكمة، وسائر ما وصف بها نفسه في كتابه.
إذ قد علمنا أن كثيراً ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته فيكون إلحاده قادحاً في توحيده، ولأنا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحد من هذه الثلاث، والإيمان بها) أ.هـ
3-قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: (وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرهاً) من آل عمران (3/336): (وله خشع من في السموات والأرض، فخضع له بالعبودية وأقر له بإفراد الربوبية، وانقاد له بإخلاص التوحيد والألوهية طوعاً وكرهاً) أ.هـ
وقد كرر هذا الأسلوب في عدة مواضع: عند آية النساء: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) وعند آية الكهف: (فليعمل عملاً صالحاً) وعند آية (ص) (وما من إله إلا الله الواحد القهار) وغيرها.
وهذا صنيع أهل العلم في كتبهم، ومن هؤلاء الإمامان ابن منده وابن خزيمة، فمن تأمل كتابيهما في "التوحيد" وتبويباتهما رأى ما ذكرناه من قبل.
المبحث الثالث: المنكرون لهذا التقسيم، وسبب إنكارهم وثمرته:
1- المنكرون لهذا التقسيم وسبب إنكارهم:
هناك من أهل الضلال ولاسيما من المتأخرين من ينكر هذا التقسيم المذكور، بل ويشبهه بتثليث النصارى والعياذ بالله، وهم عباد القبور والمفتونون بأضرحة الأولياء والصالحين.
والذي يظهر أن المتأخرين منهم إنما أنكروا ذلك لأن هذا التقسيم يكشف شركهم وما هم عليه من عبادة غير الله، ولذلك هم يقولون: "كيف يكون من يستغيث بالصالحين مشركاً وهو يؤمن بالله رباً وخالقاً ؟!!".
فإذا عرف المسلم "أقسام التوحيد" المذكورة عرف أن القوم يوحدون في باب الربوبية بالجملة، ويشركون في باب العبادة، كحال المشركين الأوائل تماماً، بل الشرك عند المتأخرين في باب "الربوبية" أكثر من الشرك عند مشركي قريش وغيرهم، على أن توحيد الربوبية وحده لا ينفع صاحبه ولا يخرجه من الكفر إلى الإسلام ولا يقيه من الخلود من النار، ولذلك يسميه بعض العلماء توحيد المشركين.
قال شيخ الإسلام كما "مجموع الفتاوى"(3/105): (فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا اله الا الله فلا يستحق العبادة أحد الا هو، وأن محمداً رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر فلا بد من الكلام فى هذين الأصلين).
وقال رحمه الله كما "مجموع الفتاوى" (14/179-180): (فهذا التوحيد توحيد الإلهية يتضمن فعل المأمور و ترك المحظور... وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين و المشركين وعليه يقع الجزاء والثواب فى الأولى والآخرة فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين فان الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون وكانوا يعبدون مع الله غيره) أ.هـ
2- ثمرة إنكارهم:
ولقد كان لهذا الإنكار ثمار سيئة على عقائد القوم، وهي كثير ولكن أكتفي بذكر بعضها:
الأول: عدم التفريق بين أنواع التوحيد، واعتقادهم أن الدعوة إلى كلمة التوحيد هي الدعوة إلى الإيمان بأن الله هو الخالق، وأن من آمن بذلك فقد دخل الإسلام وأتى بكلمة التوحيد.
الثاني: اعتقادهم بأن الرسول إنما قاتل المشركين لأنهم اعتقدوا أن الأوثان شركاء لله في خلق العالم وتدبيره، وأن اتخاذ المتأخرين الأنبياء والصالحين وسائط فيما بينهم وبين الله لا يضر إيمانهم، ما دام أنهم لم يعتقدوهم شركاء في خلق العالم وتدبيره.
الثالث: فهموا أن العبادة لله هي مجرد الخضوع للرب، والاعتراف بأفعال الرب مثل الرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر، وأن صرف بعض الأعمال كالدعاء والذبح والنذر لا يضر.
المبحث الرابع: العلاقة والفرق بين هذه الأنواع الثلاثة:
تقدم في الكلام على دلالة (لا إله إلا الله) بيان نوع العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة، فتوحيد الربوبية هو الأصل، فحق العبادة إنما ثبت بعد ثبوت الربوبية له سبحانه.
ويمكن تلخيص العلاقة بين أنواع التوحيد إلى أمور:
الأول: أن توحيد الربوبية يدل على توحيد الألوهية بدلالة الالتزام، بمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب القيام بتوحيد الألوهية، فمن عرف أن الله ربه وخالقه ومدبر أموره لزم إفراده بالعبادة، ولذلك اتخذه الله حجة على المشركين فألزمهم بتوحيد الألوهية.
قال شيخ الإسلام كما "مجموع الفتاوى" (14/180): (أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون وكانوا يعبدون مع الله غيـره ويحبونهم كما يحبونه، فكان ذلك التوحيد - الذي هو توحيد الربوبية – حجة عليهم، فإذا كان الله هو رب كل شيء و مليكه، ولا خالق ولا رازق إلا هو، فلماذا يعبدون غيره معه؟ وليس له عليهم خلق ولا رزق ولا بيده لهم منع ولا عطاء بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً) أ.هـ
الثاني: توحيد الألوهية يدل على توحيد الربوبية بالتضمن، أي: من عبد الله وحده لا شريك له فلابد أن يكون معتقداً أنه ربه وخالقه ورازقه، إذ لا يعبد إلا من بيده النفع والضر، وله الخلق والأمر.
الثالث: توحيد الربوبية ومثله توحيد الأسماء والصفات عمل قلبي في الأصل، لأنه قائم على الإقرار والاعتراف والإثبات، ولذا سمي توحيد المعرفة والإثبات، أو التوحيد العلمي، أما الألوهية فهو عمل قلبي وبدني لأنه قائم على التوجه إلى الله بالعبادة، فلا يكفي فيه عمل القلب، ولذلك سمي توحيد القصد والطلب.
المبحث الخامس: شبهة القوم في نفي هذه الأنواع:
ولهؤلاء القوم شبهات أثاروها على هذا التقسيم ظنوا أنها تنافي هذا التقسيم أو تصادمه فقد زعموا أن الرسل جاءوا لدعوة الناس إلى الإيمان بأن الله هو الخالق لكل شيء، لأن المشركين لم يكونوا يؤمنون بذلك.
وقالوا: إن الله قال في كتابه عن هؤلاء المؤمنين: (الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله)وقال: (أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله) فدل على أن المعركة كانت بين الرسل والمشركين في أصل الإيمان بالله، وأن هؤلاء المشركين لا يؤمنون بالله !!
والجواب عن الطرف الأول أن نقول:
إن هذا الذي قالوه غير صحيح لعدة أمور: منها أن هذا قول ليس له دليل يعتمد عليه، وهذا الوجه وحده كاف في نقض دعواهم، ومنها أن هذا مناقض تماماً للمعلوم من حياة الناس في عهده وقبل وبعد عهده صلى الله عليه وسلم، فمشركو "مكة" كأبي جهل وغيره، ومشركو سائر قبائل العرب كانوا يعرفون إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه مرسل من ربه، ويعظمون البيت الحرام، ويعلمون أن لهذا البيت رباً يحميه كما قال عبد المطلب لأبرهة، وهم يحجون هذا البيت ويكرمون من يأتيه من الحجاج، ويحلفون بالله في أيمانهم، ويخافون اليمين الغموس، ويخافون دعوة المظلوم ولاسيما عند البيت الحرام.
ومشركو العرب كانوا يعرفون أنواعاً من العبادات يتقربون بها إلى الله، فقد قال حكيم بن حزاملرسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت أمورا كنت أتحنث - أي: أتعبد - بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ - أي: من الأجور والثواب - فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسلمت على ما أسلفت من خير" وهو متفق عليه.
ومن ذلك النذر، ألم يقل عمر: "إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام" فقال رسول الله عليه وسلم: "أوف بنذرك" والحديث متفق عليه.
ومن ذلك الصيام، قالت عائشة رضي الله عنها:"كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية" والحديث متفق عليه.
وغير ذلك من الدلائل التي تدل على أن المشركين كانوا يعرفون الله في الجاهلية، وهذا أشهر من أن يستدل له، وإنما كانوا يعبدون الأوثان لأنهم يعتقدونها تمثل أرواح رجال صالحين يشفعون لهم عند الله كما ذكر ذلك ربنا في كتابه الكريم حيث قال: (والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى)، لكنهم (إذا ركبوافي الفلك دعوا الله مخلصين له الدين) وتركوا ما هم عليه من الشرك، فجاءت الرسل تدعو الناس إلى عبادة الله وحده، ونبذ ما يعبد من دونه من الأوثان والأصنام، فهذا هو موضع النزاع بين الرسل وأممهم، ولاسيما بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والكفار.
والجواب عن الطرف الثاني أن نقول:
إن كلمتي (رب) و (إله) من الألفاظ التي إذا اجتمعت في النص الواحد افترقت في المعنى، وإذا افترقت في النص فذكر أحدهما دون الآخر دخل الآخر في المعنى مثل (الفقير) و (المسكين)، و(التوبة) و(الاستغفار) و(الإيمان) و (الإسلام) ونحو ذلك.
ومن ذلك قوله تعالى: (قل أعوذ برب الناس0ملك الناس0إله الناس)، ولذلك إذا سئل الميت في قبره: (من ربك ؟!) كان المراد من معبودك ؟! وليس المراد من خلقك لأن الكفار يقرون بأن الله هو الخالق.
ومما يدل على أن أحدهما إذا أطلق دخل الآخر فيه حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه حين سمع قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم),قال يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم) الترمذي وحسنه، وحسنه كذلك الألباني في "غاية المرام" برقم (6).
والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لعدي الآية وفيها ذكر اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباّ من دون الله، ففهم عدي عبادتهم من دون الله فقال: (إنهم لم يعبدوهم) مما يدل على أن (الرب) إذا كان لفظاً مفرداً دخل فيه معنى المعبود.
ومن هنا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في (الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب) ضمن (الدرر السنية): (فاعلم أن الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان كما في قوله: (قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس)، وكما يقال: (رب العالمين وإله المرسلين)، وعند الإفراد يجتمعان كما في قول القائل: (من ربك)، مثاله الفقير والمسكين نوعان في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، ونوع واحد في قوله: (افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم).
إذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر: من ربك ؟ معناه من إلهك، لأن الربوبية التي أقر بها المشركون ما يمتحن أحد بها، وكذلك قوله: (الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله) وقوله: (قل أغير الله أبغي رباً) وقوله : (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا)، فالربوبية في هذا هي الألوهية ليست قسيمة لها كما تكون قسيمة لها عند الاقتران فينبغي التفطن لهذه المسألة) أ.هـ
هذا ونسأل الله الثبات لنا ولكم على دينه وسنة نبيه محمد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
انتهت الحلقة الثانية من (دروس في التوحيد)
كتبه: أبو عمار علي الحذيفي.
عدن / اليمن.
أبو عمار علي الحذيفي
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:
فهذه هي الحلقة الثانية من (دروس في التوحيد) نـتكلم فيها عن "حقيقة التوحيد الذي بعث الله به الرسل". وتتكون هذه الحلقة من عدة فصول:
الأول: تعريف التوحيد: ويتكون من عدة مباحث:
المبحث الأول: معنى التوحيد.
المبحث الثاني: الأدلة على كلمة "توحيد".
المبحث الثالث: أركان التوحيد.
الثاني: توحيد الربوبية: ويتكون من عدة مباحث:
المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية، وأدلته.
المبحث الثاني: معاني الربوبية ترجع إلى ثلاثة الخلق والملك التدبير.
المبحث الثالث: إقرار المشركين بهذا التوحيد.
المبحث الرابع: إقرار المشركين به كان ناقصاً.
الثالث: توحيد الألوهية: ويتكون من عدة مباحث:
الأول: تعريف توحيد الألوهية، وأدلته.
الثاني: توحيد الألوهية هو المقصد من بعثة الرسل.
الثالث: وقت وقوع الشرك في الأمم، وكيفية وقوعه.
الرابع: خلاصة ما تقدم.
الرابع: توحيد الأسماء والصفات: ويتكون من عدة مباحث:
الأول: تعريفتوحيد الأسماء والصفات، وأدلته.
الثاني: الأمور التي يقوم عليها توحيد الأسماء والصفات.
الخامس: أنواع التوحيد: ويتكون من عدة مباحث:
المبحث الأول: ذكر الأنواع إجمالاً قبل تفصيلها.
المبحث الثاني: أدلة هذا التقسيم.
المبحث الثالث: المنكرون لهذا التقسيم وسبب الإنكار وثمرته.
المبحث الرابع: العلاقة والفرق بين هذه الأنواع الثلاثة.
المبحث الخامس:شبه القوم في نفي هذه الأنواع.
هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لها القبول عنده سبحانه، ثم عند خلقه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
الفصل الأول: تعريـف التوحــيد:
كثير من الناس يعرف فضل التوحيد، لكن صورة التوحيد التي بعث الله بها الرسل وحقيقته غير واضحة عنده، وإذا كان هذا يقع فيه كثير من أصحاب الشهادات ممن ينتسب إلى الفقه والتصوف وغيرهم، فكيف بغيرهم من الناس ؟! ولذلك أحببنا أن نبين "حقيقة التوحيد" في هذه الفصول التي نرجو من الله أن تساعد القارئ المبتدئ على تكوين صورة واضحة عن حقيقة التوحيد التي بعث الله بها الرسل.
المبحث الأول: معنى التوحيد:
التوحيد لغة: مصدر وحد يوحد توحيداً، أي: جعل الشيء واحداً،والتوحيد هو مصدر وحد على وزن فعّل بتشديد العين المهملة، وكل ما كان على وزن (فعّل) فمصدره على وزن (تفعيل) نحو درس يدرس تدريساً، وشغل يشغل تشغيلاً، وكلم يكلم تكليماً ومنه الآية: (وكلم الله موسى تكليماً) ونحو ذلك.
والتوحيد شرعاً: إفراد الله تعالى بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا يعني تنوع التوحيد إلى ثلاثة أنواع سيأتي الكلام عليها.
فالتوحيد في أصل اللغة والشريعة هو بمعنى الإفراد، فالتوحيد هو إفراده سبحانه بهذه الخصائص التي تفرد بها، فلا يشاركه فيها أحد مهما علت منزلته سواء كان ملكاً مقرباً أو نبياً مرسلاً أو رجلاً صالحاً.
وينبغي أن يعلم أن التوحيد بأنواعه لا يقوم حتى يجتمع الإقرار به في قلب العبد وعلى لسانه، والعمل به بجوارحه.
قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي في "كشف الشبهات": (لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلماً).
المبحث الثاني: الأدلة على كلمة "توحيد":
يزعم أعداء التوحيد أن كلمة "توحيد" كلمة مبتدعة ليس لها أصل وهذا قول باطل، فإن أصل كلمة التوحيد معروف في اللغة كما تقدم، ومعروف في الشريعة أيضاً، ونحن سنسوق هنا بعض الأدلة على أنها معروفة أيضاً.
أدلة القرآن:
قال تعالى: (وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً) وقال تعالى: (وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة)وقال تعالى: (ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير)وقال: (قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده) وقال: (وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده) وقال: (وما من إله إلا إله واحد) وقال: (وإلهكم إله واحد) وقال: (قل هو الله أحد) ونحو ذلك.
أدلة السنة:
1- قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن: (إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى) وهو في "الصحيحين" وهذا لفظ البخاري.
2- وقال صلى الله عليه وسلم: (من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه، حرم ماله ودمه، وحسابه على الله) رواه مسلم وغيره عن طارق بن أشيم.
3- وفي حديث عمرو بن عبسة الطويل في "صحيح مسلم" وهو حديث مشهور قال عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم: (فقلت له ما أنت؟ قال: (أنا نبي) فقلت وما نبي؟ قال: (أرسلني الله) فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: (أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء).
4- وقال صلى الله عليه وسلم: (بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت) رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه، واللفظ لمسلم.
5- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة، وإن هشاماً نحر حصته خمسين بدنة وإن عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: (أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه لنفعه ذلك) رواه أحمد، وهو في "الصحيحة" برقم: (484).
6- وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في "صحيح مسلم" في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: (حتى إذا كان بالبيداء أهل بالتوحيد).
المبحث الثالث: أركان التوحيد:
1- ركنا التوحيد النفي والإثبات:
للتوحيد ركنان لا يُستغنى عنهما: الأول: هو النفي، والثاني: هو الإثبات، فلا يكون التوحيد توحيداً إلا بهذين الركنين، فالنفي فيه سلب ما يختص بالله عن غير الله، والإثبات فيه إفراد الله بهذه الأمور.
ونضرب على هذا مثالاً فنقول: لو أردنا أن نفرد زيداً بالعلم من بين الناس في بلد من البلدان، فلا يكفي أن نقول: (زيد عالم) لأن هذا فيه إثبات العلم لزيد لكن ليس فيه إفراد زيد بالعلم فيبقى احتمال أن هناك عالماً غيره، ولو قلنا: (لا عالم في البلد) لكنا قد نفينا العلم عن الجميع، وهذا فيه تعطيل، فالعبارة السـليمة أن نقول: (لا عالم إلا زيد) فنكون قد نفينا العلم عن غير زيد، وأثبتناه له وحده فقط.
ولذلك فألفاظ القرآن كلها في هذا الباب تدل على هذا الإفراد الذي ذكرناه بجميع صوره المعروفة في اللغة العربية، وصوره في اللغة العربية هي:
الأولى: تقديم ما حقه التأخير، مثل الظرف والجار والمجرور، وإنما قلنا حقها التأخير لأنها تأتي دائماً خبراً للمبتدأ على أحد الإعرابين، أو تتعلق بخبر محذوف على الإعراب الآخر، فإذا كانت كذلك فقد تقدمت فهي تفيد الحصر، مثل: (فابتغوا عند الله الرزق) ولم يقل: "فابتغوا الرزق عند الله"، فقوله: "فابتغوا عند الله الرزق" أي: عند الله وحده.
الثانية: أو تقديم المعمول مثل: (إياك نعبد، وإياك نستعين) والشاهد تقديم ضمير النصب، والمعنى: نعبدك وحدك، ونستعين بك وحدك.
الثالثة: النفي ثم الاستثناء، كقوله تعالى: (وما النصر إلا من عند الله)، وسواء كان الاستثناء بإلا أو غيرها من أدوات الاستثناء.
الرابعة: بوجود "إنما" بكسر الهمزة، كقوله تعالى: "يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي".
الخامسة: تعريف المبتدأ والخبر مثل: "الله الصمد"، والصَّمد: هو السيد العظيم الذي تُصْمد إليه الحوائج، أي يُقصد بها، والمعنى الله الذي يقصد بالحوائج، لا يُقصد بالحوائج والسؤال إلا هو وحده.
وإليك بعض هذا الإفراد المستفاد من الصور المتقدمة، فمن ذلك قوله تعالى: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) وهذا أمر بعبادة الله ونهي عن صرف العبادة لغيره فهذا توحيد، وقوله: (فاعلم أنه لا إله إلا الله) وهذا نفي وإثبات فهو توحيد، وقوله: (واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني لكم نذير مبين) وقوله تعالى: (ألا تعبدوا إلا الله) فيه النهي عن عبادة غير الله والأمر بعبادته وحده فدل على التوحيد، وقوله: (قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده) كذلك، وغير ذلك من الآيات.
2- معنى النفي الكفر بالطاغوت، ومعنى الإثبات والإيمان بالله:
واعلم أن النفي يحمل معنى الكفر بالطاغوت، وأن الإثبات يحمل معنى الإيمان بالله، والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هما الجناحان اللذان يطير بهما طائر التوحيد، كما قال تعالى: (فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى) وكلمة التقوى والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، وقال تعالى: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) فالإيمان بالله وحده متوقف على الكفر بالطاغوت.
ومن هنا نعلم خطورة دعوى "حرية الاعتقاد" على عقيدة التوحيد ومصادمتها لهذه العقيدة العظيمة، لأن الكفر بالطاغوت منـزوع من قانون "حرية الاعتقاد"، فحرية الاعتقاد تعطي الحق لمن شاء أن يعبد ما شاء من الأوثان، في الوقت الذي تمنع الآخرين من الاعتراض عليه أو رد باطله، ولا شك أن هذا مصادم للكفر بالطاغوت الذي هو الركن الأول من أركان التوحيد، لأن الكفر بالطاغوت يوجب على الموحد التبرؤ من عبادة غير الله ومعاداة أهله صراحة وبكل وضوح، وهذا غير ما تجنيه هذه الدعوة المنحرفة على الجهاد في سبيل الله وهدم معالم الشرك، لأنه فرع الكفر الطاغوت.
والخلاصة أن دعوى "حرية الاعتقاد" تجني على مقاصد التوحيد وووسائله، ففيها فساد الدنيا والآخرة.
الفصل الثاني: توحيد الربوبية:
المبحث الأول: تعريف توحيد الربوبية، وأدلته:
1- تعريف توحيد الربوبية:
توحيد الربوبية: هو إفراد الله تعالى بأفعاله الدالة على ربوبيته التي لا يشاركه فيها أحد، كخلق الخلق وتدبيرهم والقيام على مصالحهم ومعايشهم وما تفرع من ذلك، لأن الرب عند العرب هو السيد المالك، فمعناه يتعلق بملكه وتدبيره ورعايته.
وأصل هذا التوحيد هو الاعتراف بأن الله هو الرب المتفرد بالخلق والملك والتدبير، ولذلك كان الأصل في هذا التوحيد أنه مما يتعلق بعمل القلب، والبدن تابع له، بخلاف توحيد الألوهية فإنه يتعلق بالقلب والبدن معاً.
2- أدلة توحيد الربوبية:
وتوحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى في ثلاثة أمور:
الأول الخلق: أي: أنه لا يقدر على الخلق إلا الله، والأدلة على ذلك كثيرة قال تعالى: (والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون) وقال تعالى: (أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم) وقال: (الله خالق كل شيء) وقال: (إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له) وقال: (هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه) وقال: (أفمن يخلق كمن لا يخلق) وقال: (واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون) وقال: (قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض) وقال: (قل هل من شركاءكم من يبدأ الخلق ثم يعيده) والآيات في ذلك كثيرة.
والمراد بالخلق هنا إيجاد الشيء من العدم وهذا لا يقدر عليه إلا الله، وإنما نقول ذلك لأن القبورية أثبتوا أن هناك من يخلق مع الله، بحجة أن الله أثبت خالقين آخرين غيره سبحانه، واستدلوا بقوله تعالى: (فتبارك الله أحسن الخالقين).
والجواب: أن الخلق الذي ينسب إلى المخلوق هو من باب تحويل الشيء من صورة إلى أخرى، كتحويل الطين إلى إبريق، وتحويل الخشب إلى دولاب، والماء إلى برد وثلج ونحو ذلك، وليس الخلق الذي هو إيجاد الشيء من العدم.
على أنه ينبغي التنبيه إلى أن بعض التحويل من شيء إلى شيء آخر هو بمنزلة إيجاد الشيء من العدم لا يقدر عليه إلا الله فقط، حتى المخلوق لا يقدر عليه، كتحويل النطفة منها إلى علقة والعلقة إلى مضغة والمضغة إلى عظام العظام إلى لحم ونحو ذلك.
والضابط في ذلك أن المخلوق لا يقدر على تحويل الشيء من صورة إلى أخرى إلا بوجود الأسباب التي هيأها الله، والخالق يقدر على ذلك بقوله كن فيكون.
الثاني الملك: أي: أنه تعالى متفرد بالملك، والأدلة في ذلك كثيرة، قال تعالى: (قل اللهم مالك الملك) وقال: (تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير) وقال: ( ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض) وقال: (ذلكم الله ربكم له الملك) وقال: (وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك) وقال: (لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء) وقال: (له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى) وقال: (قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه) والآيات في ذلك كثيرة.
وتأمل في قوله تعالى: (بيده الملك) وقوله: (بيده ملكوت) وقوله: (له الملك) وقوله: (له ملك السموات ..) وقوله: (له ما في السموات والأرض) ونحو ذلك، تعرف إفراد الله بهذه المعاني بما تقدم من أساليب وطرق الإفراد في اللغة.
الثالث التدبير: أي: أنه تعالى متفرد بتدبير الأمور، وتصريف هذا الكون، قال تعالى: (وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون) وقال: (يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه) وقال: (قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يـدبر الأَمـر) والآيات في إثبات تفرد الله بتصريف الأمور، وتدبير المعايش كثيرة.
المبحث الثاني: معاني الربوبية ترجع إلى ثلاثة الخلق والملك والتدبير:
وهناك معاني كثيرة أخرى من معاني الربوبية مثل الرزق والقبض والبسط، والإحياء والإماتة، وهبة الولد، وشفاء المريض، والنصر على العدو ونحو ذلك،وهي كثيرة نذكر منها:
1- الضر والنفع: فقد قال الله تعالى: (قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا) وقال تعالى: (ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك) وغير ذلك من الآيات.
والعلة من ذكر تفرده بالضر والنفع أن انتفاء ذلك عن هذه المعبودات دليل على عجزها في نفسها، فضلاً عن أن تملك لغيرها شيئاً، وأن الذي يستحق أن يعبد رغبة ورهبة هو الله لأنه مالك ذلك كله.
2- ومن ذلك الرزق: فهو الذي يسوقه ويأتي به ويسهله للخلائق، وكل ما يجده الناس في معايشهم من الأرزاق فهو من فضله وكرمه سبحانه وحده لا يشاركه في ذلك أحد.
قال تعالى: (إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له) فنفى أن يكون غيره يملك شيئاً من الرزق ولو يسيراً، وعرفنا ذلك بالأسلوب البلاغي في وجود النكرة في سياق النفي فنستفيد العموم أي: لا يملكون رزق المال ولا الأولاد ولا الطعام ولا الشراب ولا العافية ولا غير ذلك، ثم أمر بالتوجه إلى الله وحده وذلك بتقديم ما حقه التأخير حيث قدم الظرف فقال: (عند الله الرزق) ولم يقل: فابتغوا الرزق عند الله.
وقال تعالى: (هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض) فأفرد نفسه بالرزق ونفاه عن غيره، لأن هذا استفهام يراد به النفي، ومن ذلك قوله تعالى: (إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) وغير ذلك.
3- ومن ذلك شفاء المريض: فهو وحده الذي يشفي من المرض كما قال تعالى عن إبراهيم: (وإذا مرضت فهو يشفين) وفي الرقية كما في الحديث: (لا شفاء إلا شفاؤك).
4- ومن ذلك كشف الضرر: فإنه لا يقدر عليه إلا الله، كما قال تعالى: (وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو) وقال: (قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره) وقال: (فلما كشفنا عنهم الرجز) وقال تعالى: (فلما كشفنا عنه ضره) وغير ذلك من الآيات.
5- ومن ذلك أنه هو المتفرد بالرفع والخفض: كما قال تعالى: (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) وقال: (ورفعنا لك ذكرك) وقال: (نرفع درجات من نشاء) وقال: (تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء) إلى غير ذلك من الآيات.
6- ومن ذلك هبة الولد وإخراجه من بطن أمه: قال تعالى: (يهب لم يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور) وقال عن زكريا عليه السلام: (فاستجبنا له ووهبنا له يحي) وقال: (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً) وقال: (ثم السبيل يسره) وقال: (ثم نخرجكم طفلاً).
7- ومن ذلك هداية القلوب وتسديدها وتوفيقها: قال تعالى: (من يهد الله فهو المهتد) ويقول: (إنك لا تهدي من أحببت) وقال: (وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله) وغير ذلك من الآيات.
8- ومن ذلك النصر على العدو: كما قال تعالى: (وما النصر إلا من عند الله) وقال: (ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير) وقال: (إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده).
9- ومن التأليف بين القلوب: كما قال تعالى: (هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم) وقال: (واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً).
وغير ذلك من معاني الربوبية كالإحياء والإماتة، والقبض والبسط، والإعطاء والمنع وغير ذلك،وكلها ترجع إلى الخلق والملك والتدبير.
المبحث الثالث: إقرار المشركين بهذا التوحيد:
والمشركون كانوا يقرون بربوبية الله تعالى، وأنه خالق كل شيء كما في كثير من الآيات، منها قوله سبحانه وتعالى: (ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم) وقوله سبحانه وتعالى: (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) وقوله سبحانه وتعالى: (قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون0سيقولون لله قل أفلا تذكرون0قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم0سيقولون لله قل أفلا تتقون0قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون0سيقولون لله قل فأنى تسحرون).
فهؤلاء الآيات بينت أن الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب المتفرد بالخلق والملك والتدبير كان مستقراً في نفوس المشركين، وأنهم لم يكونوا ينازعون في قضية ربوبية الله سبحانه وتعالى، ولم ينازعوا في أنه رب السموات والأرض، وأنه خالق الخلق ورازقهم سبحانه وتعالى، وإنما كانوا ينازعون في توحيد الله بالعبادة، فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه الأوثان والأصنام.
قال شيخ الإسلام كما "مجموع الفتاوى"(3/97): (وقد أخبر سبحانه عن المشركين من إقرارهم بأن الله خالق المخلوقات ما بينه فى كتابه). ثم ساق بعض الآيات الدالة على ذلك.
وقال النعمي في "معارج الألباب إلى مناهج الحق والصواب": (ولقد تتبعنا في كتاب الله فصول تراكيبه، وأصول أساليبه، فلم نجده تعالى حكى عن المشركين أن عقيدتهم في آلهتهم وشركائهم التي عبدوها من دونه أنها تخلق وترزق وتحي وتميت وتنزل من السماء ماء، وتخرج الحي من الميت، والميت من الحي).
وقال: (ومن أمعن النظر في آيات الكتاب وما قص من محاورات الرسل مع أممهم وجد أن أس الشأن، ومحط رحال القصد شيوعاً، وكثرة وانتشاراً وشهرة هو دعاء الله وحده وإخلاص العبادة له).
ونحب أن ننبه إلى أننا نقول: إن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، ولا يلزم من ذلك أنهم كانوا موحدين توحيداً صحيحاً مقبولاً.
وهناك شبهة للقبوريين في هذا العصر الذين ينكرون تقسيم التوحيد إلى عدة أقسام، والآيات التي فيها اعتراف المشركين ترد عليهم، لذلك قالوا: هذا الإقرار إنما قاله مشركو قريش نفاقاً، ولم يكونوا يعترفون بذلك في قرارة نفوسهم.
ويكفي أن نذكر وجهين في الجواب عن هذه الشبهة: الأول: هؤلاء الآيات مكية، والنفاق لم يظهر في مكة، وإنما ظهر في المدينة عندما قوي الاسلام بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فخاف بعض الناس أن يظهر الكفر فكان ينافق، أما في مكة فكانوا يجاهرون بالكفر، فما هناك أي ضرورة تحتم عليهم أن ينافقوا.
الثاني: أنهم لو كانوا منافقين في هذا الاعتراف والإقرار لعقَّب عليهم ربنا سبحانه وتعالى، وبين أنهم يقولون هذا عن نفاق لا عن تسليم وقناعة، وقد بين سبحانه وتعالى في أكثر من آية ما يقوله المنافقون من الكذب ويتعقبهم سبحانه وتعالى كما في قوله سبحانه وتعالى: (سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا) قال الله عز وجل بعدها: (يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم).
وآية أخرى وهي قوله سبحانه وتعالى: (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون)، والشهادة: هي تواطؤ اللسان والقلب على شيء، ومن المعروف أن المنافقين يقولون هذا بألسنتهم دون الإقرار بقلوبهم، فبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الأقوال يقولها المنافقون عن غير اعتقاد، وأنهم يكذبون في هذا الشهادة، فمن هنا نعرف أن إقرار كفار العرب بالربوبية عن إقرار حقيقي منهم، فلو كان كفار قريش كاذبين في هذا الإقرار لما أقرهم الله عز وجل.
المبحث الرابع: إقرار المشركين به كان ناقصاً:
وأيضاً نريد أن ننبه إلى مسألة مهمة وهي أن مشركي العرب عموماً، و مشركي قريش خصوصاً كانوا مقرين بتوحيد الربوبية بالجملة ولكن لم يكونوا مقرين به كاملاً، ولم يقروا به على الوجه المطلوب، بل كان عندهم خلل في توحيد الربوبية.
فمثال ذلك: أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث، فقد آمنوا بأن الله خلقهم لكن لم يؤمنوا بأن الله سيبعثهم، فهم آمنوا بالمبدأ ولم يؤمنوا بالمعاد، وأيضاً كانوا يستسقون بالأنواء بحيث إنهم يستسقون ببعض النجوم وبعض الأنواء والمنازل، كذلك كانوا يعلقون التمائم، والتمائم: "جمع تميمة وهي ما يعلقها الإنسان من جلد أو من خشب أو غير ذلك يريد بها دفع ضرر يتوقع حصوله، أو رفع ضرر قد حصل" فهم يعلقونها ويعتقد بعضهم أنها تنفع بإذن الله أو بنفسها، وكان فيهم التطير، وكان فيهم أشياء أخرى مما يخل بتوحيد الربوبية، ولكن بالجملة كان عندهم الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب الخالق والمالك والرازق والمتصرف في هذا الكون سبحانه وتعالى.
قال شيخ الإسلام كما في "درء تعارض العقل والنقل" (5/156): (وهم مع شركهم وما يلزمهم من نوع تعطيل في الربوبية لا يثبتون مع الله شريكاً مساوياً له في أفعاله ولا في صفاته).
وقال المقريزي في "تجريد التوحيد المفيد": (فأبان سبحانه بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الألوهية لا توحيد الربوبية، على أن منهم من أشرك في الربوبية كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله).
الفصل الثالث: توحيد الألوهية:
المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية، وأدلته:
1- تعريف توحيد الألوهية:
توحيد الألوهية: هو إفراد الله بأفعال العباد، أي: بعبادتهم فقط، وليس المقصود إفراده تعالى بجميع أفعال العباد، فإن من أفعالهم ما هو من قسم المباحات كالأكل والشرب وغيرهما.
وهذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، فإن هذه الكلمة تدل على توحيد الألوهية بدلالة المطابقة كما تقدم.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: (وأحسن ما يعرف هذا التوحيد هو قوله تعالى: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) وقوله: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه) أ.هـ
ويسمى توحيد الألوهية والإلهية وتوحيد العبادة ونحو ذلك.
قال الشيخ ابن سعدي في "القواعد الحسان": (ويقال له توحيد الإلهية، فإن الإلهية وصفه تعالى الذي ينبغي أن يؤمن به كل بني آدم، ويوقنوا أنه الوصف الملازم له سبحانه الدال عليها الاسم العظيم وهو الله، وهو مستلزم جميع صفات الكمال، ويقال له: توحيد العبادة باعتبار وجوب ملازمة وصف العبودية بكل معانيها للعبد بإخلاص العبادة لله تعالى، وتحقيقها في العبد أن يكون عارفاً بربه، مخلصاً جميع عبادته محققاً ذلك بترك الشرك صغيره وكبيره).
2- أدلة توحيد الألوهية:
وهذه الألوهية تعني تفرد الرب بحق العبادة فلا يشاركه في ذلك أحد، قال تعالى: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) وقال: (وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه) وقال: (إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه) وقال: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم) – إلى قوله: - (فلا تجعلوا لله أنداداً) وقال: (قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون) وقال: (قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دونه) وقال: (قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب) وقال: (وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله) وقال: (واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله) وقال الله عن الكفار أنهم قالوا: (أجئتنا لنعبد الله وحده).
الثاني: توحيد الألوهية هو المقصد الأعظم من بعثة الرسل:
1- توحيد الألوهية هو دعوة الرسل في الأصل:
والمقصود الأعظم من دعوة الرسل هو تحقيق هذا التوحيد، وإن كانوا أيضاً قد جاءوا لتحقيق سائر أنواع التوحيد، لكن هذا التوحيد كان في المقدمة لأن الشرك الذي وقع للأمم كان من جهته.
فتوحيد العبادة أمرت به جميع الشرائع، وأقامته جميع الملل كما قال تعالى: (ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) وقال تعالى: (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون)وقال تعالى: (لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره) وغير ذلك من الآيات، وقد تقدم هذا في الدرس الأول "مكانة التوحيد".
والمشركون أنفسهم فهموا هذا الذي ذكرناه من أن الرسل بعثوا لينهوا أممهم عن عبادة غير الله فقال الله عنهم: (قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده) وقال: (أجعل الآلهة إلهاً واحداً).
2- أسلوب القرآن في الدعوة إلى الألوهية:
وللقرآن أسلوب خاص في دعوته إلى توحيد الألوهية فمن ذلك:
1- إلزام من أقر بالربوبية بتوحيد الألوهية، فالله يعلم أن مشركي قريش يقرون في باب الربوبية بالجملة، ويعلمون في قرارة أنفسهم أنه لا يشارك الله أحد في ربوبيته للخلائق، فجعل إقرارهم هذا ملزماً لهم في توحيد العبادة في أكثر من آية.
قال شيخ الإسلام كما "مجموع الفتاوى" (14/180): (أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون وكانوا يعبدون مع الله غيره ويحبونهم كما يحبونه، فكان ذلك التوحيد - الذي هو توحيد الربوبية - حجة عليهم).
وقال ابن القيم في "طريق الهجرتين" (56-57): (ولهذا كانت لا إله إلا الله أفضل الحسنات، وكان توحيد الإلهية الذي كلمته لا إله إلا الله رأس الأمر، فأما توحيد الربوبية الذي أقر به كل المخلوقات فلا يكفي وحده وإن كان لا بد منه وهو حجة على من أنكر توحيد الألوهية).
ومن هؤلاء الآيات قوله تعالى: (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون) والمراد كما أشار غير واحد من المفسرين أنه إذا أقررتم أنه الخالق لكم ولغيركم فكيف تعبدون غيره ؟!
قال ابن كثير عند هذه الآية: (ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غَيره).
وقال رحمه الله عند آيتي العنكبوت (ولئن سألتهم): (وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية فإن المشركين كانوا يعترفون بذلك).
2- ومنها بيان أن الله خلق الخلق لعبادته وحده سبحانه، وأن الذي صرف العبادة لغيره لم يحقق العبودية المطلوبة لله والعبادة المطلقة، وأن الله لم يخلق الناس عبثاً، ولم يتركهم سدى لا يؤمرون ولا ينهون، بل خلقهم لعمارة هذا الكون بالطاعة والعبادة.
3- ومنها أنه خاطبهم على قدر عقولهم فضرب له الأمثلة الكثيرة ومنها: أنه أخبر أن السيد كما أنه لا يسره أن يشاركه عبده ومملوكه في ماله فكذلك الله جل وعلا لا يحب أن يشاركه أحد، فهكذا الرب الذي يخلق الخلق ثم يعبدون غيره.
قال تعالى: (ضَرب لكم مثلاً من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون).
قال ابن كثير في "تفسيره": (هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به العابدين معه غيره، الجاعلين له شركاء وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له ملك له، لا يرتضي أحد منكم أن يكون عبده شريكًا له في ماله، فهو وهو فيه على السواء، تخافون أن يقاسموكم الأموال) أ.هـ
3- خطأ من يرى أن توحيد الربوبية هو غاية دعوة الرسل وغيرها:
وهناك من الطوائف من ترى أن الغاية الذي بعث الله لها الرسل هو الإيمان بأن الله هو الخالق والمدبر للخلائق وهذا غير صحيح.
قال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" (3/97-98): (وبهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط في مسمى التوحيد، فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد فى كتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة أنواع: فيقولون هو واحد فى ذاته لا قسيم له، وواحد فى صفاته لا شبيه له، وواحد فى أفعاله لا شريك له.
وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث وهو توحيد الأفعال، وهو أن خالق العالم واحد، وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرها، ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب، وأن هذا هو معنى قولنا: (لا اله الا الله) حتى يجعلوا معنى الإلهية القدرة على الاختراع.
ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه و سلم أولا لم يكونوا يخالفونه فى هذا بل كانوا يقرون بأن الله خالق كل شيء حتى أنهم كانوا يقرون بالقدر أيضا وهم مع هذا مشركون، فقد تبين أن ليس فى العالم من ينازع فى أصل هذا الشرك) أ.هـ
وقال ابن القيم في "طريق الهجرتين" (ص30): (وغاية هذا الفناء في توحيد الربوبية وهو أن لا يشهد رباً وخالقاً ومدبراً إلا الله، وهذا هو الحق ولكن توحيد الربوبية وحده لا يكفي في النجاة فضلاً عن أن يكون شهوده والفناء فيه هو غاية الموحدين ونهاية مطلبهم، فالغاية التي لا غاية وراءها ولا نهاية بعدها الفناء في توحيد الإلهية).
وقال ابن القيم في "طريق الهجرتين" (56-57): (ولهذا كانت لا إله إلا الله أفضل الحسنات، وكان توحيد الإلهية الذي كلمته لا إله إلا الله رأس الأمر، فأما توحيد الربوبية الذي أقر به كل المخلوقات فلا يكفي وحده وإن كان لا بد منه وهو حجة على من أنكر توحيد الألوهية).
الثالث: وقت وقوع الشرك في الأمم، وكيفية وقوعه:
روى البخاري في "صحيحه" برقم: (4920) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير، لآل ذي الكلاع، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون أنصاباً، وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت).
قال شيخ الإسلام كما في "مجموع الفتاوى" (1/167): (وقد استفاض عن ابن عباس وغيره في "صحيح البخاري" وفي كتب التفسير وقصص الأنبياء في قوله: (وقالوا لا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً) أن هؤلاء كانوا قوماً صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم، قال ابن عباس: ثم صارت هؤلاء الأوثان في قبائل العرب) أ.هـ
ثم جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فبقي الناس على ملته حتى جاء من غير ملته فأحيى عبادة الأصنام مرة أخرى، وكان أول من أحيا عبادة الأصنام بين العرب هو عمرو بن لحي الخزاعي، فقد كان الناس على ملة إبراهيم حتى جاء هذا الرجل فأخرجها في بعض أسفاره من الرمال بوحي من الشيطان فنقلها إلى جزيرة العرب، ودعا الناس إلى عبادتها فاستجابوا له لما له بينهم من جاه وسلطان.
قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": (وقد أخرج الفاكهي من طريق ابن الكلبي قال: " كان لعمرو بن ربيعة رئي من الجن فأتاه فقال: أجب أبا ثمامة، وادخل بلا ملامة ثم ائت سِيْفَ جدَّة، تجد بها أصناماً معدة، ثم أوردها تهامة ولا تهب، ثم ادع العرب إلى عبادتها تجب، قال فأتى عمرو ساحل جدة فوجد بها وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً، وهي الأصنام التي عبدت على عهد نوح وإدريس، ثم إن الطوفان طرحها هناك فسفى عليها الرمل فاستثارها عمرو وخرج بها إلى تهامة وحضر الموسم فدعا إلى عبادتها فأجيب) أ.هـ
المبحث الرابع: خلاصة ما تقدم:
حتى لا يبقى القارئ مشتتاً بين هذه المباحث أحببنا أن نلخص له ما تقدم ذكره إلى أمور، فنقول وبالله التوفيق:
الأول: أن الناس كانوا على الفطرة والتوحيد حتى وقع الشرك في قوم نوح أو قبلهم بقليل ثم سارت الأمم على هذه الطريقة، يخرجهم الشيطان عن فطرتهم بهذا النوع من الشرك.
الثاني: أن شركهم لم يكن من جهة اعتقاد أن هناك من يتصرف في هذا الكون مع الله أو أنه يخلق أو يرزق أو غير ذلك من معاني الربوبية، وإنما لكونهم صرفوا العبادة لغير الله.
الثالث: أن عباد الأوثان لم يكونوا يعتقدون أن هذه المعبودات تضر وتنفع بنفسها، ولكن صرفوا لها العبادة لتقربهم إلى الله زلفى فقط، لما يرونه من فضل هؤلاء الصالحين وقربهم من الله.
الرابع: أن الرسل إنما جاءت لإفراد الله بالعبادة، وبينت أن صرف العبادة لغير الله من الشرك العظيم الذي يوجب قتال أهله، وأن حسن النية التي يتحجج بها هؤلاء لا تنفعهم عند الله.
وقد تشذ عما ذكرناه بعض الصور، ولكن هذا نادر ولا يؤثر فيما تقدم، والأصل ما ذكرناه.
الفصل الرابع: توحيد الأسماء والصفات:
الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات، وأدلته:
1- تعريف توحيد الأسماء والصفات:
وتوحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله تعالى بأسمائه وصفاته التي وصف بها نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، مع الإقرار بمعانيها إثباتاً بلا تمثيل، وتنزيهاً بلا تعطيل.
والأسماء: هي الكلمات الدالة على ذاته مثل الرحمن والرحيم والعزيز والغفور ونحوها.
والصفات: هي المعاني القائمة بالذات كالرحمة والعزة ونحوهما.
وهذا التوحيد مندرج في الأصل في توحيد الربوبية.
قال الشيخ الفوزان في "شرح كتاب التوحيد": (النوع الثالث: وهو توحيد الأسماء والصفات، فهو في الحقيقة داخل في توحيد الربوبية، ومن أجل هذا بعض العلماء يجمل ويجعل التوحيد نوعين:
توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وهو التوحيد العلمي، وتوحيد في الطلب والقصد وهو التوحيد الطلبي العملي، وهو توحيد الألوهية) أ.هـ
2- أدلتــه:
وعندنا على هذا التوحيد أدلة كثيرة مستفيضة من الكتاب والسنة كقوله تعالى: (ولله المثل الأعلى) أي: الوصف الأعلى وقوله تعالى: (ليس كمثله شيء) وقوله: (ولم يكن له كفوا أحد) وقوله: (هل تعلم له سمياً) وقوله: (فلا تجعلوا لله أنداداً) والند يكون في الصفات كما يكون في الربوبية والألوهية، ونحو ذلك من الأدلة التي تبين تفرده بهذه الأسماء والصفات التي سمى بها نفسه بها أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم.
الثاني: الأمور التي يقوم عليها توحيد الأسماء والصفات:
وتوحيد الأسماء والصفات مبني على أمور لا يقوم توحيد الأسماء والصفات إلا بها:
الأول: أن يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وينفي ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن نعتقد أن هذه الأسماء والصفات خاصة بالله، لا يشاركه فيها أحد من الخلق مهما علت منزلته، أو عظمت مكانته، فلا نصف أحداً من الخلق بعلم الغيب أو العلو المطلق أو الاستواء على العرش أو نحو ذلك من الصفات، ولا نسميه بالأسماء الخاصة بالله كالرحمن أو الإله أو الرب أو الله أو نحو ذلك من الأسماء.
الثالث: إثبات المعاني الواردة في النصوص على ما يليق بالله تعالى إثباتا بلا تمثيل.
الرابع: أن نفوض الكيفية فلا نخوض فيها لأننا لا نعلمها كما قال الإمام مالك: (الاستواء معلوم، والكيف مجهول).
فإذا سار العبد على هذه الأصول العظيمة سلم له معتقده في باب "الأسماء والصفات".
الفصل الخامس: أنواع التوحيد:
المبحث الأول: ذكر أنواع التوحيد إجمالاً قبل تفصيلها:
التوحيد ثلاثة أنواع هي: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وهذه الأنواع الثلاثة لابد للعبد من الإتيان بها كلها، ولا نجاة له إلا بذلك.
وفي الوقت نفسه لا بد من التفريق فيما بينها، بمعنى أنها ليست توحيداً واحداً كما يظن من لم يعرف حقيقة التوحيد، فبعض الطوائف يظنون أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية واحد لا فرق بينهما، ولذلك فهم يرون غاية دعوة الرسل هو الإيمان بأن الله هو الخالق، وأن من آمن بذلك فقد أتى بكلمة التوحيد، فأنتج هذا القول ثماراً سيئةً منها أن التوحيد المطلوب من الناس أن الله هو الخالق القادر على خلق الشيء من العدم، وعليه فإنهم لا يعدون صرف شيء من العبادة لغير الله مناقضاً للتوحيد.
ونحن سنذكر هذه الأنواع الثلاثة مع ذكر ما استطعنا من الأدلة عليها، والله الموفق.
المبحث الثاني: أدلة هذا التقسيم:
تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام دليله ثلاثة أشياء: الاستقراء التام، ودلالة كلمة لا إله إلا الله، وتنصيص السلف وأئمة الدين والعلم.
الدليل الأول الاستقراء التام:
والاستقراء التام: هو الحكم على شيء كلي بواسطة إثباته بالتتبع والتصفح لجميع الجزئيات، وهو حجة بإجماع الأصوليين.
قال الشنقيطي في "الأضواء": (وقد تقرر في الأصول: أن الاستقراء من الأدلة الشرعية، ونوع الاستقراء المعروف عندهم بالاستقراء التام حجة بلا خلاف، وهو عند أكثرهم دليل قطعي).
وقال الشنقيطي في "الأضواء" في موضع: (وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: توحيده في ربوبيته، وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء، قال تعال: (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) وقال: (قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون) وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله: (قال فرعون وما رب العالمين) تجاهل من عارف أنه عبد مربوب بدليل قوله تعالى: (قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر)، وقوله: (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلواً) وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله. كما قال تعالى: (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) والآيات الدالة على ذلك كثيرة جداً.
الثاني: توحيده جل وعلا في عبادته، وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى: (لا إله إلا الله) وهي متركبة من نفي وإثبات، وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد، وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم (أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب).
النوع الثالث: توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته، وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين:
الأول: تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم، كما قال تعالى: (ليس كمثله شيء).
والثاني: الإيمان بما وصف الله به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بكماله وجلاله، كما قال بعد قوله: (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) أ.هـ باختصار.
وأقول إن كثيراً من أبواب العلم بنيت على الاستقراء، ومن ذلك أن النحويين قسموا الكلمة إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، ودليلهم على هذا استقراء تام لكلام العرب، والصوفية القبورية يسلمون بهذا التقسيم ولا يناقشون فيه، وحجة هذا التقسيم هو حجة تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، مع أن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أظهر وأبين وأوضح، لأن أدلته هي الكتاب والسنة وقد نطق به السلف الصالح، وسيأتي معنا بعض الآيات الدالة على هذا الشيء.
وإذا قلنا: إن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح، فهل يمكن أن يقال: إن هذا لم ينص عليه الشرع وإنما هو تثليث، وإن كان العلماء يستندون في ذلك التقسيم إلى نصوص الشريعة ويعتمدون على استقراء تام لها ؟!
فقولنا: "الإيمان: قول وعمل واعتقاد" لم يدل عليه دليل شرعي يحمل هذا اللفظ، وإنما هو مأخوذ من جملة الأدلة، ومعتمد على استقرائها، وإنما ذكر العلماء هذا التفصيل لما ظهرت الأقوال الزائغة.
وأيضاً تقسيم الكلمة إلى ثلاث أقسام: الاسم، والفعل، والحرف الذي جاء لمعنى، وهو شيء يعرفه "الصوفية"، فهل العرب نصت على هذا التقسيم بعينه ؟!
وأيضاً أغلب هؤلاء القبوريين على عقيدة "الأشاعرة" وهم يقولون: إن توحيد الله ينبني على ثلاثة أشياء:
توحيد الذات، توحيد الصفات، توحيد الأفعال، وهذا التقسيم عليه ملاحظات كثيرة من حيث هو، ولكن أردنا أن نبين أن القبوريين المنكرين للتقسيم العلمي للتوحيد، هم أنفسهم يقرون بتقسيم آخر وإن كان ليس مبنياً على أسس صحيحة.
الدليل الثاني دلالة كلمة "لا إله إلا الله":
فكلمة التوحيد تدل على إفراد الله بالعبادة بدلالة المطابقة، لأن معنى "كلمة التوحيد": "لا إله إلا الله" هو إفراد الله بحق العبادة ونفي هذا الحق عن غيره، و"الإله" لا يكون مستحقاً لهذه العبادة إلا إذا كان رباً خالقاً مدبراً لمصالح عباده، فهذا توحيد الربوبية وقد عرفناه بدلالة التضمن، والرب موصوف بصفات الكمال والجلال، وهذا توحيد للأسماء والصفات، وقد عرفناه بدلالة الالتزام.
الدليل الثالث: طريقة السلف، وتنصيص الأئمة:
قال سبحانه وتعالى: (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) فأثبت سبحانه وتعالى في الآية إيماناً للمشركين من جهة، وشركاً وقعوا فيه من جهة أخرى، فقد قال العلماء في معنى الآية: (وما يؤمن أكثرهم بالله) أي: في جانب الربوبية (إلا وهم مشركون) أي: في جانب العبادة.
قال ابن كثير في تفسيره في "تفسيره" "سورة يوسف" قال ابن عباس: "من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم: من خلق السموات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال ؟ قالوا: الله، وهم مشركون به" يعني في العبادة).
قال ابن كثير: (وكذا قال مجاهد وعطاء وعكرمة والشعبي وقتادة والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم).
وللأئمة كلام نصوا على هذا التفصيل والتقسيم ونقلوه عن غيرهم، ويكفي أن أذكر ثلاثة من هؤلاء الأئمة الذين شهد لهم الناس بإمامتهم بالعلم، وسنشير إلى الباقي:
1- ما قاله الطحاوي في أول "عقيدته": (نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له، ولاشيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره).
فقوله: (ولا شيء مثله) فيه الإشارة إلى توحيد الأسماء والصفات، وقوله: (ولا شيء يعجزه) فيه إشارة إلى توحيد الربوبية، وقوله: (ولا إله غيره) فيه إشارة إلى توحيد الألوهية.
وهذا التفصيل عليه أئمة الحنفية وهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت، ثم محمد بن الحسن، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، وقد أشار الطحاوي في مقدمة "عقيدته" إلى أن رسالته هذه هي على معتقد الأئمة الثلاثة.
2- ما قاله ابن بطة في "الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية": (وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء:
أحدها: أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مبايناً لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعاً.
والثاني: أن يعتقد وحدانيته، ليكون مبايناً بذلك مذاهب أهل الشرك، الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره.
والثالث: أن يعتقده موصوفاً بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفاً بها من العلم والقدرة والحكمة، وسائر ما وصف بها نفسه في كتابه.
إذ قد علمنا أن كثيراً ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته فيكون إلحاده قادحاً في توحيده، ولأنا نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحد من هذه الثلاث، والإيمان بها) أ.هـ
3-قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: (وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرهاً) من آل عمران (3/336): (وله خشع من في السموات والأرض، فخضع له بالعبودية وأقر له بإفراد الربوبية، وانقاد له بإخلاص التوحيد والألوهية طوعاً وكرهاً) أ.هـ
وقد كرر هذا الأسلوب في عدة مواضع: عند آية النساء: (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً) وعند آية الكهف: (فليعمل عملاً صالحاً) وعند آية (ص) (وما من إله إلا الله الواحد القهار) وغيرها.
وهذا صنيع أهل العلم في كتبهم، ومن هؤلاء الإمامان ابن منده وابن خزيمة، فمن تأمل كتابيهما في "التوحيد" وتبويباتهما رأى ما ذكرناه من قبل.
المبحث الثالث: المنكرون لهذا التقسيم، وسبب إنكارهم وثمرته:
1- المنكرون لهذا التقسيم وسبب إنكارهم:
هناك من أهل الضلال ولاسيما من المتأخرين من ينكر هذا التقسيم المذكور، بل ويشبهه بتثليث النصارى والعياذ بالله، وهم عباد القبور والمفتونون بأضرحة الأولياء والصالحين.
والذي يظهر أن المتأخرين منهم إنما أنكروا ذلك لأن هذا التقسيم يكشف شركهم وما هم عليه من عبادة غير الله، ولذلك هم يقولون: "كيف يكون من يستغيث بالصالحين مشركاً وهو يؤمن بالله رباً وخالقاً ؟!!".
فإذا عرف المسلم "أقسام التوحيد" المذكورة عرف أن القوم يوحدون في باب الربوبية بالجملة، ويشركون في باب العبادة، كحال المشركين الأوائل تماماً، بل الشرك عند المتأخرين في باب "الربوبية" أكثر من الشرك عند مشركي قريش وغيرهم، على أن توحيد الربوبية وحده لا ينفع صاحبه ولا يخرجه من الكفر إلى الإسلام ولا يقيه من الخلود من النار، ولذلك يسميه بعض العلماء توحيد المشركين.
قال شيخ الإسلام كما "مجموع الفتاوى"(3/105): (فإقرار المشرك بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه لا ينجيه من عذاب الله إن لم يقترن به إقراره بأنه لا اله الا الله فلا يستحق العبادة أحد الا هو، وأن محمداً رسول الله فيجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر فلا بد من الكلام فى هذين الأصلين).
وقال رحمه الله كما "مجموع الفتاوى" (14/179-180): (فهذا التوحيد توحيد الإلهية يتضمن فعل المأمور و ترك المحظور... وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين و المشركين وعليه يقع الجزاء والثواب فى الأولى والآخرة فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين فان الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون وكانوا يعبدون مع الله غيره) أ.هـ
2- ثمرة إنكارهم:
ولقد كان لهذا الإنكار ثمار سيئة على عقائد القوم، وهي كثير ولكن أكتفي بذكر بعضها:
الأول: عدم التفريق بين أنواع التوحيد، واعتقادهم أن الدعوة إلى كلمة التوحيد هي الدعوة إلى الإيمان بأن الله هو الخالق، وأن من آمن بذلك فقد دخل الإسلام وأتى بكلمة التوحيد.
الثاني: اعتقادهم بأن الرسول إنما قاتل المشركين لأنهم اعتقدوا أن الأوثان شركاء لله في خلق العالم وتدبيره، وأن اتخاذ المتأخرين الأنبياء والصالحين وسائط فيما بينهم وبين الله لا يضر إيمانهم، ما دام أنهم لم يعتقدوهم شركاء في خلق العالم وتدبيره.
الثالث: فهموا أن العبادة لله هي مجرد الخضوع للرب، والاعتراف بأفعال الرب مثل الرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر، وأن صرف بعض الأعمال كالدعاء والذبح والنذر لا يضر.
المبحث الرابع: العلاقة والفرق بين هذه الأنواع الثلاثة:
تقدم في الكلام على دلالة (لا إله إلا الله) بيان نوع العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة، فتوحيد الربوبية هو الأصل، فحق العبادة إنما ثبت بعد ثبوت الربوبية له سبحانه.
ويمكن تلخيص العلاقة بين أنواع التوحيد إلى أمور:
الأول: أن توحيد الربوبية يدل على توحيد الألوهية بدلالة الالتزام، بمعنى أن الإقرار بتوحيد الربوبية يوجب القيام بتوحيد الألوهية، فمن عرف أن الله ربه وخالقه ومدبر أموره لزم إفراده بالعبادة، ولذلك اتخذه الله حجة على المشركين فألزمهم بتوحيد الألوهية.
قال شيخ الإسلام كما "مجموع الفتاوى" (14/180): (أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون وكانوا يعبدون مع الله غيـره ويحبونهم كما يحبونه، فكان ذلك التوحيد - الذي هو توحيد الربوبية – حجة عليهم، فإذا كان الله هو رب كل شيء و مليكه، ولا خالق ولا رازق إلا هو، فلماذا يعبدون غيره معه؟ وليس له عليهم خلق ولا رزق ولا بيده لهم منع ولا عطاء بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً) أ.هـ
الثاني: توحيد الألوهية يدل على توحيد الربوبية بالتضمن، أي: من عبد الله وحده لا شريك له فلابد أن يكون معتقداً أنه ربه وخالقه ورازقه، إذ لا يعبد إلا من بيده النفع والضر، وله الخلق والأمر.
الثالث: توحيد الربوبية ومثله توحيد الأسماء والصفات عمل قلبي في الأصل، لأنه قائم على الإقرار والاعتراف والإثبات، ولذا سمي توحيد المعرفة والإثبات، أو التوحيد العلمي، أما الألوهية فهو عمل قلبي وبدني لأنه قائم على التوجه إلى الله بالعبادة، فلا يكفي فيه عمل القلب، ولذلك سمي توحيد القصد والطلب.
المبحث الخامس: شبهة القوم في نفي هذه الأنواع:
ولهؤلاء القوم شبهات أثاروها على هذا التقسيم ظنوا أنها تنافي هذا التقسيم أو تصادمه فقد زعموا أن الرسل جاءوا لدعوة الناس إلى الإيمان بأن الله هو الخالق لكل شيء، لأن المشركين لم يكونوا يؤمنون بذلك.
وقالوا: إن الله قال في كتابه عن هؤلاء المؤمنين: (الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله)وقال: (أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله) فدل على أن المعركة كانت بين الرسل والمشركين في أصل الإيمان بالله، وأن هؤلاء المشركين لا يؤمنون بالله !!
والجواب عن الطرف الأول أن نقول:
إن هذا الذي قالوه غير صحيح لعدة أمور: منها أن هذا قول ليس له دليل يعتمد عليه، وهذا الوجه وحده كاف في نقض دعواهم، ومنها أن هذا مناقض تماماً للمعلوم من حياة الناس في عهده وقبل وبعد عهده صلى الله عليه وسلم، فمشركو "مكة" كأبي جهل وغيره، ومشركو سائر قبائل العرب كانوا يعرفون إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه مرسل من ربه، ويعظمون البيت الحرام، ويعلمون أن لهذا البيت رباً يحميه كما قال عبد المطلب لأبرهة، وهم يحجون هذا البيت ويكرمون من يأتيه من الحجاج، ويحلفون بالله في أيمانهم، ويخافون اليمين الغموس، ويخافون دعوة المظلوم ولاسيما عند البيت الحرام.
ومشركو العرب كانوا يعرفون أنواعاً من العبادات يتقربون بها إلى الله، فقد قال حكيم بن حزاملرسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت أمورا كنت أتحنث - أي: أتعبد - بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ - أي: من الأجور والثواب - فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسلمت على ما أسلفت من خير" وهو متفق عليه.
ومن ذلك النذر، ألم يقل عمر: "إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام" فقال رسول الله عليه وسلم: "أوف بنذرك" والحديث متفق عليه.
ومن ذلك الصيام، قالت عائشة رضي الله عنها:"كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية" والحديث متفق عليه.
وغير ذلك من الدلائل التي تدل على أن المشركين كانوا يعرفون الله في الجاهلية، وهذا أشهر من أن يستدل له، وإنما كانوا يعبدون الأوثان لأنهم يعتقدونها تمثل أرواح رجال صالحين يشفعون لهم عند الله كما ذكر ذلك ربنا في كتابه الكريم حيث قال: (والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى)، لكنهم (إذا ركبوافي الفلك دعوا الله مخلصين له الدين) وتركوا ما هم عليه من الشرك، فجاءت الرسل تدعو الناس إلى عبادة الله وحده، ونبذ ما يعبد من دونه من الأوثان والأصنام، فهذا هو موضع النزاع بين الرسل وأممهم، ولاسيما بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والكفار.
والجواب عن الطرف الثاني أن نقول:
إن كلمتي (رب) و (إله) من الألفاظ التي إذا اجتمعت في النص الواحد افترقت في المعنى، وإذا افترقت في النص فذكر أحدهما دون الآخر دخل الآخر في المعنى مثل (الفقير) و (المسكين)، و(التوبة) و(الاستغفار) و(الإيمان) و (الإسلام) ونحو ذلك.
ومن ذلك قوله تعالى: (قل أعوذ برب الناس0ملك الناس0إله الناس)، ولذلك إذا سئل الميت في قبره: (من ربك ؟!) كان المراد من معبودك ؟! وليس المراد من خلقك لأن الكفار يقرون بأن الله هو الخالق.
ومما يدل على أن أحدهما إذا أطلق دخل الآخر فيه حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه حين سمع قوله تعالى: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم),قال يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم فقال بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم) الترمذي وحسنه، وحسنه كذلك الألباني في "غاية المرام" برقم (6).
والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لعدي الآية وفيها ذكر اتخاذ الأحبار والرهبان أرباباّ من دون الله، ففهم عدي عبادتهم من دون الله فقال: (إنهم لم يعبدوهم) مما يدل على أن (الرب) إذا كان لفظاً مفرداً دخل فيه معنى المعبود.
ومن هنا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في (الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب) ضمن (الدرر السنية): (فاعلم أن الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان كما في قوله: (قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس)، وكما يقال: (رب العالمين وإله المرسلين)، وعند الإفراد يجتمعان كما في قول القائل: (من ربك)، مثاله الفقير والمسكين نوعان في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين)، ونوع واحد في قوله: (افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم).
إذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر: من ربك ؟ معناه من إلهك، لأن الربوبية التي أقر بها المشركون ما يمتحن أحد بها، وكذلك قوله: (الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله) وقوله: (قل أغير الله أبغي رباً) وقوله : (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا)، فالربوبية في هذا هي الألوهية ليست قسيمة لها كما تكون قسيمة لها عند الاقتران فينبغي التفطن لهذه المسألة) أ.هـ
هذا ونسأل الله الثبات لنا ولكم على دينه وسنة نبيه محمد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
انتهت الحلقة الثانية من (دروس في التوحيد)
كتبه: أبو عمار علي الحذيفي.
عدن / اليمن.

0 commentaires :
إرسال تعليق